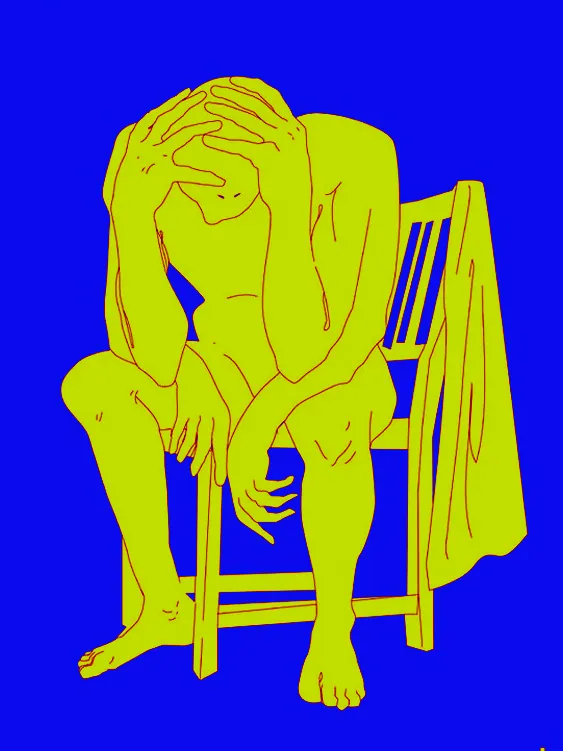العام 1983، والأمريكي العادي صار يشرب في الثمانينيات ثلاثة أضعاف كمية المياه الغازية التي كان يشربها نظيره في الخمسينيات.[1]
في ذلك العام، أصدر مايكل جاكسون ألبومه الأيقوني Thriller، ليحصد 7 جوائز غرامي، وليصبح الألبوم الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة على الإطلاق، وكانت شركة كوكاكولا تتربع على عرش سوق المشروبات الغازية، متفوقةً بمسافة كبيرة على منافستها التقليدية بيبسي.
في نفس العام، رفضت كوكاكولا ضمنيًا التعاقد مع جاكسون كوجه لحملاتها الإعلانية، بعد أن قدمت عرضًا له بمليون دولار فقط، بالمقارنة بخمسة أضعاف المبلغ، عرضتها بيبسي.
حملة بيبسي كانت بعنوان “جيل جديد”، وقد وصلت بالمبيعات إلى رقم 7.7 مليار دولار، مع زيادة في حصتها من السوق على حساب كوكاكولا، باستهدافها للشرائح العُمرية الشابة، في مقابل كوكاكولا التي اختارت النقيض تمامًا، باختيارها للكوميدي الأمريكي بيل كوسبي في نهاية أربعينياته.
والسؤال هو: لماذا تنجح حملة إعلانية عن “مشروب” _أو تفشل أخرى_ لمجرد تصدّر مطرب أو ممثل لحملة إعلانية، وإذا افترضنا أن المشروب نفسه يُباع بنفس السعر ولا زال يحتفظ بنفس الطَعم؟
الإجابة المختصرة هي:
لقد استغلوا ما يُسمى “الرغبة المحاكاتية” أو Mimetic Desire، والمصطلح هنا للفيلسوف رينيه جيرارد.
جيرارد يرى أن قيمة الأشياء لدينا ليست موضوعية إطلاقًا، بل ذاتية، وتلك القيمة الذاتية تحددها علاقاتنا بمن نعرفهم، وتحديدًا: من نُعجب بهم، ومن نثمّن توجيهاتهم.
تخيّل حيرتك المعتادة أمام صف القمصان في أي محل ملابس. أغلب القمصان تبدو متشابهة، إلى أن يصيح بك رفيقك في رحلة البحث عن قميص: هذا يليق بك. الآن كفّ القميص عن كونه مجرد قميص، بل “هو القميص الذي أعجب به معاذ”، ومعاذ في قصتنا هذه “أشيك حد في الشلة”.
هذا النموذج للرغبة يُلغي تصورنا البديهي _الأشبه بخط مستقيم_ عن الرغبة.
يفرق جيرارد في نظريته بين “الحاجات” و”الرغبات”. الحاجات لديه هي الأشياء الأكثر أساسية، التي نحتاجها لنظل على قيد الحياة، كالطعام والجنس، أما الرغبات فهي ما نسعى إليه دون آلية مدمجة “Built-in” داخلنا.
اختيارك للقميص المذكور أعلاه، أو تخصصك في الكلية، أو لون موبايلك أو طرازه، كلها تفتقر إلى هذا الخط المستقيم المتخيّل بينك وبين ما تريد، وتُخل _غالبًا_ بتصورك عن نفسك، ككائن حر الإرادة، يُفضل البيبسي على الكوكاكولا، لأنك في نموذج الرغبة الذي اقترحه جيرارد تفضل ما تفضله لأن “من تراهم قدوة” يفضلونه، حتى وإن كنت لا تعي ذلك.
لكن تصوّر شخص ما بمثابة قدوة، ولو كان ذلك على مستوى العقل الباطن، ليس شكل التأثر الوحيد في نظرية جيرارد، فلأن الكثير مما نرغبه محدود (لا يمكن لنا جميعًا أن نفوز بالمركز الأول في مسابقة ما)، تولد المنافسة، والعداء (Rivalry) حسب تعبير جيرارد، خاصةً إذا كنا نتنافس على ما لا نستطيع مشاركته مع غيرنا (فرصة وحيدة للفوز بالمركز الأول في مسابقة) أو ما لا نرغب في مشاركته مع غيرنا كذلك (أن تكون أقرب أصدقاء فلان مثلًا).
وباتساع دائرتك الاجتماعية، خصوصًا مع هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا اليومية، تتزايد فرص التأثر والمقارنة والعداء.
هنا من حقنا أن نتساءل عن تأثير الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على رغباتنا، خصوصًا إذا كان هذا الإفراط في كثير من الأحيان مدمجًا في تصميم منصات التواصل الاجتماعي نفسها، وقائمًا على آلية عصبية، هي انطلاق الدوبامين (هرمون المتعة والمكافأة) استجابةً لتسجيلات الإعجاب، والتعليقات، والمشاركات.
في نوفمبر 2022، نُشرت دراسة لاستخدام البالغين اللبنانيين لوسائل التواصل الاجتماعي في ظل جائحة كورورنا والوضع الاقتصادي المتدهور بلبنان.
نلاحظ في هذه الدراسة، أنه رغم تدهور الوضع الاقتصادي، فإن نسبة مستخدمي الهواتف الذكية القادرين على الوصول إلى الإنترنت في لبنان ارتفعت من 57% في 2015 إلى 80% في 2017، بالمقارنة بنسبة 53% من الفرنسيين البالغين، و20% من الهنود البالغين.
في لبنان _حسب الدراسة_ ارتبطت الأزمات المتتالية التي مر بها اللبنانيون بحالة من التوتر المزمن، والاستخدام “الإدماني” لوسائل التواصل الاجتماعي. وتكشف الدراسة عن علاقة تناسب عكسي بين الاستخدام “غير السليم” لوسائل التواصل الاجتماعي وارتفاع معدلات الاندفاع في اتخاذ القرارات.
حاليًا، تمر مصر كذلك بأزمات اقتصادية متتالية تخلق حالة توتر مزمن شبيهة بما عاناه اللبنانيون، وربما تدفع سكانها إلى درجة مشابهة من التعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي اعترف فيه 48-50% من سكان دول الخليج بدرجة ما من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، بالمقارنة بنسبة 25% فقط في دولة كالفلبين.
الناقدون لأفكار رينيه جيرار، يرون فيها تبسيطًا مخلًا للسلوك البشري، وإهمالًا لدور الإرادة الحرة، وإهمالًا للتباينات بين الثقافات والسياقات الاجتماعية المختلفة.
كذلك، فالتأثر ليس بالضرورة “سيئًا” في كل حالاته، بل وربما كان دافعًا إلى تغيير إيجابي.
فإذا كانت الرغبة تتشكل دون وعي منا، تأثرًا بمن حولنا، فلدينا قدر لا بأس به من الاستقلالية في “اختيار” دائرة المحيطين بنا ممن “نوَد” نتأثر بهم.
لذلك، في المرة القادمة التي يخطر ببالك فيها أن تضغط زر المتابعة، أو الموافقة على الصداقة، أو طلب تواصل على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، فكّر للحظة:
هل تريد حقًا أن تتأثر رغباتك _وقراراتك بالتالي_ بوجود هذا الشخص في دائرة معارفك؟
[1] https://www.telegraph.co.uk/music/artists/pepsi-nearly-killed-michael-jackson-story-behind-controversial/