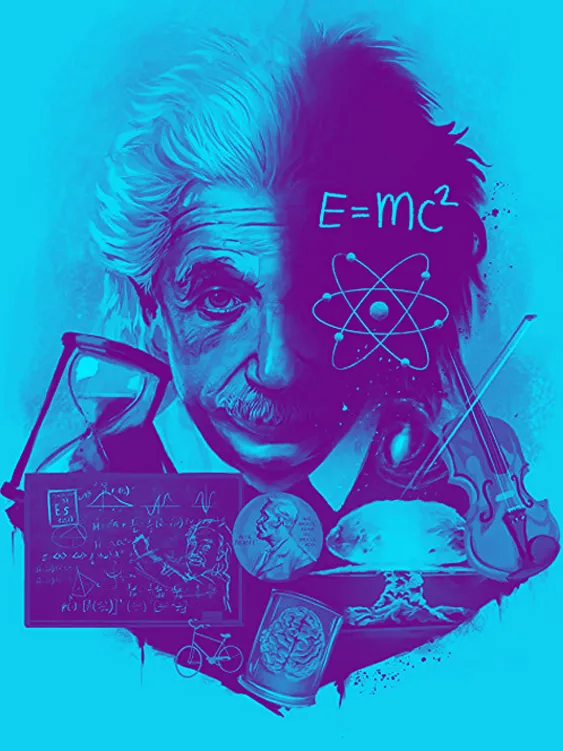لابد أن الكثيرين غيري، قد قرؤوا ملخصات كثيرة لنظرية النسبية، وشاهدوا وثائقيات لا تحصى، ولابد أنهم، مثلي، قد أحسوا في كل مرة، أنهم اقتربوا جدا من فهمها، وإن كانوا غير متأكدين من ذلك. وأتصور أن بعضهم، مثلي، ضحكوا في داخلهم، من المفارقة، وهو يقرؤون الجملة المنسوبة لأينشتاين: “إذا لم تستطع شرح فكرتك لطفل عمره 6 أعوام، فأنت نفسك لم تفهمها جيدًا”.
ولأقول صادقًا، فقدت بدت لي، دائمًا، هذه المقولة، غبية جدًا. وسأشرح لماذا؟
النكتة غير المشروحة
كل مجال، له لغته التقنية الخاصة، مهما كان هذا المجال. المشتغلون في حقل علمي أو عملي محدد يستخدمون مفردات معينة، ليست لها ذات المعاني(الدلالات) في اللغة العادية. يصدق هذا على العلوم الإنسانية، والطبيعية، ويصدق على الخبرة الحياتية، حيث يستخدم كل أفراد تجمعهم ممارسة ما، مصطلحات خاصة بهم. هذه المصطلحات نشأت نتيجة نقاش داخلي بينهم، وأصبحت دلالة كل مصطلح، تدل على شئ ما، اتفقوا عليه أثناء نقاشاتهم. مثلًا يستخدم طلبة كليات الهندسة في مصر، وربما بعض الكليات الأخرى، مصطلحًا خاصًا، للدلالة على قيامهم “بنقل رسمة هندسية ما” من لوحة إلى أخرى، عن طريق وضع لوحة فارغة فوق اللوحة المرسومة، بشكل متطابق، وكلا اللوحتين فوق زجاج موضوع تحته مصدر ضوئي. وينتج عن ذلك، ظهور خطوط اللوحة المرسومة واضحة على اللوحة الفارغة، ولا يتبقى سوى استعمال القلم الرصاص والأدوات الهندسية البسيطة، كالمسطرة والبرجل والمنقلة، لنقل الخطوط بشكل ممتاز.
لكن مصطلح “الفونسة”، والذي أتى حسبما أعتقد لأن المصدر الضوئي الذي استعمل في بداية نشأة هذه التقنية كان الفانوس، يحمل معاني أخرى، بجانب معناه التقني المباشر، فبالنسبة للطلبة، ترتبط “الفونسة” بضغط التسليمات المطلوبة منهم، وعدم التمكن من استكمالها في الوقت المحدد، واضطرارهم إلى اللجوء لهذه التقنية، في أجواء يختلط فيها التوتر من الوقت الضيق، مع المرح، الناتج عن قدرتهم على مراوغة “الانضباط” المطلوب منهم، والإفلات بفعلتهم من آليات الضبط والمعاقبة داخل الكلية. إنه مصطلح “رفاقي”، فلا يمكن لشخص واحد أن “يفونس” لوحة، دون يعطيه زميله لوحة مكتملة بالفعل. ولهذا كثيرًا ما يحضر المصطلح، لدى الطلاب، عند تذكر الكلية وأيامها، خاصة عند من تمثل لهم الحياة الجامعية بضغوطها، نمطًا متحررًا في الحياة، مقارنة ببيئات العمل بعد ذلك.
وإنه أمر مكرر، أن نجد أنفسنا في جلسة، ويقول أحدهم كلمة ما، فيضحك الجميع، بينما نحن لا نستطيع الإمساك بسبب الضحك. يحدث هذا أكثر حين نجد أنفسنا في مكان ما، مع أشخاص لهم تاريخ أطول في هذا المكان، وليكن مكان عمل. إنهم يطورون نكتهم الخاصة، أو بالتعبير الدارج inside jokes، نتيجة لنقاشات ومواقف خاضوها سوية، وسنحتاج لبعض من الوقت والدأب والرغبة في الانتماء، حتى نجد أنفسنا جزءًا من هذه المجموعة، ونضحك على ما يضحكهم. فبالوقت، سنسألهم لماذا يضحكون على هذه الكلمة، ويحكون لنا الموقف، وبحكايتهم لنا، نصير جزء من هذا التقليد، ويعتبروننا أعضاء معهم في نفس الرابطة. ويحدث، أحيانًا، ألا نجد أنفسنا راغبين في الانتماء إليهم، لأسباب مختلفة، ونحتمي بجهلنا، كحاجز يقينا من ضغط الانتماء، الذي يشكله تواجدنا في مكان واحد مع الآخرين.
هذه التجربة، تشبه تجربتنا في القراءة، فكثيرًا ما نبدأ بقراءة كتاب ما، وتستغلق علينا لغته تمامًا، فنغلقه أحيانًا، وأحيانًا أخرى نحاول البدء في كتاب أبسط في نفس المجال موجه لغير المتخصصين، ليكون بإمكاننا بعدها قراءة الكتاب الأول. فكل كاتب في مجال ما، كالفلسفة مثلًا، يستخدم مصطلحات يعلم معناها لدى العاملين الآخرين في المجال، إذ أنهم جميعًا قد اشتركوا، في وقت ما، في قراءة كتب معينة، استخدمت هذه المصطلحات، مع شرح كيفية التوصل إليها ولماذا، بينما يكون القارئ غير المنتمي لهذا المجال، ولم يسبق له قراءة تلك الكتب والدخول في نقاشات بخصوصها، قدرته على فهم هذه المصطلحات، محصورة في مدى اقتراب دلالة هذه المصطلحات داخل المجال، من دلالتها في اللغة العادية التي يستعملها. ولذلك تساعدنا الكتب الموجهة لغير المتخصصين، في أن نبدأ قراءة الكتب الأكثر تخصصًا، إنها بشكل ما، تشرح لنا “النكتة” التي لم نفهمها.
إن الكاتب، أي كاتب، وهو يكتب يستحضر في ذهنه، عددًا من النقاشات التي سبق وحضرها، ويختار قارئه المثالي، من حيث هو القارئ الذي يكون مر بمواقف ونقاشات شبيهة بتلك التي يستحضرها. لكن هذه العملية، لا تكلل دائمًا بالنجاح الكامل، فقد أكتب مثلًا، كتابًا أتحدث فيه عن تطور الفكر الفلسفي الحديث، وأبدأ الكتاب، في الحديث من مفكر معين، وفجأة أقول “وهذا ما يخالف نظرية أرسطوطاليس”، معتبرًا أن القارئ لابد أنه يعلم من هو أرسطو، ثم يعلم أيضًا نظريته في هذه المسألة، ثم هو أيضًا يرى بوضوح، كيف تخالف النظرية الأولى نظرية أرسطو، دون حاجة، لأي توضيح إضافي. بل قد يعرف القارئ أرسطو ونظريته في هذه المسألة فعلًا، لكنه، لا يدري أن أرسطو هو نفسه أرسطوطاليس، وإن اختلاف الاسمين، ناتج عن اختلاف تعريب الإسم، مع ثبات حاملهما. وقد يقرر القارئ عند هذه اللحظة، ترك الكتاب نهائيًا، أو بالبحث عن هذا الأرسطوطاليس ثم العودة للكتاب، وقد يقرر، كما أفعل غالبًا، المضي في القراءة، آملًا بعدم أهمية هذه الفقرة بأكملها، وهو أمل غالبًا، وبالتجربة، ما لا يتحقق كاملًا، ولا يفشل تمامًا.
المهم، أنني كنت أفكر وأكتب، في معضلة سوء الفهم هذه، الناتجة عن اختلاف النقاش الذي يفترض الكاتب العلم به، عن النقاش الحاضر فعلًا في ذهن قارئ ما، عندما جاءت إلى بالي، مقولة أينشتاين، هذه، وبدت لي غبية، لأنني فهمت أن أينشتاين يعتقد بقدرة أي كاتب، أو متكلم، على إيصال فكرة معينة، لطفل عمره ست سنوات، وهو ما يرتبط بالضرورة بتخلي هذا المتحدث عن أي “مصطلحات” ، أو الاستناد إلى نقاش سابق معلوم لدى الطفل، عن هذا المجال. إنه أمر شبه مستحيل، في حالة المجالات العلمية والنظرية، المبنية على تراكم هائل من الحقائق والنظريات والنقاشات. وبالتالي، في مجالات عديدة، يكون استخدام اللغة العالية، أو الاصطلاحية الخاصة بالمجال، أمر شبه حتمي، للمحافظة على “الدقة الدلالية” لكل مصطلح. وإبراءً للذمة وأنا أكتب، قررت أن أستخدم تعبير “الجملة المنسوبة لأينشتاين” بدلًا من “جملة أينشتاين الشهيرة”، بما أني لم أسمع أينشتاين ولم أقرأ كتاب له، ولا أعلم إن كان قالها فعلًا أو لا، ثم بدا لي أن هذا النهج الحذر، كسولًا جدًا، وغير أمين، والأنسب أن أبحث فعلًا إن كان قالها أم لا.
البحث عن طفل أينشتاين
بمجرد البحث بالانجليزية، وكما هو متوقع، يمتلئ الفضاء الالكتروني، بمئات من المتسائلين مثلي عن صحة نسبة مقولة أينشتاين له، وهناك في المقابل، المئات من الإجابات، بعضها ينسب الجملة لفيزيائيين آخرين، مثل ماري كوري أو ريتشارد فاينمان، بعضها الآخر يحاول تتبع “أقرب” ما قاله أينشتاين لهذا المعنى. أحد هذه الإجابات ادعت أن أينشتاين قال “معظم الأفكار الأساسية للعلوم بسيطة في جوهرها، ويمكن، كقاعدة عامة، التعبير عنها بلغة يفهمها للجميع”، وأحالتني إلى مقال في ينتشر عام 1938، يتحدث عن كتاب مشترك بين أينشتاين والعالم الفيزيائي ليوبولد إنفيلد ، كتاب “تطور علم الطبيعة”، لكن المقولة ليست موجودة كما هي في المقال الذي يتحدث عن الكتاب، والذي يقول فيه الكاتب إن “الكتاب موجه للقارئ العادي غير المتخصص، ومع ذلك فإن القارئ سيشعر، بعدم ارتياح، أثناء القراءة، كأن هناك شئ ما مفقود دائمًا”، وينقل عن أينشتاين ورفيقه قولهم إن “هدفنا يتحقق..إذا نجحت هذه الصفحات في إعطائك فكرة ما عن الصراع الداخلي داخل العقل الإنساني المبدع، من أجل فهم قوانين الظواهر الفيزيائية”. المهم، قررت قراءة الكتاب، ووجدته مترجمًا للعربية، وبمجرد قراءة المقدمة، وجدت أن أينشتاين، يعي صعوبة شرح النظريات الفيزيائية بشكل تام لغير المتخصص، بل ووجدته ورفيقه يقولون إننا ” تناقشنا طويلا حين شرعنا في وضع هذا الكتاب في المميزات التي يجب أن تتوفر في قارئنا المثالي، وشغلنا هذا الموضوع كثيرا، وقد تخيلنا أن القارئ سيستعيض عن عدم درايته التامة بعلمي الطبيعة والرياضة بالتحلي بكثير من الخصال الحميدة، فمثلا تخيلناه مهتما بالآراء الطبيعية والفلسفية، وكان علينا أن نعجب بصبره الذي استعان به في تتبع الفقرات المملة أو الصعبة، وتخيلنا هذا القارئ يقنع بأنه لكي يفهم أي صفحة، عليه أن يقرأ الصفحات السابقة بعناية، فهو يعلم أن من الخطأ أن يقرأ الكتاب العلمي ، حتى لو كان مبسطا، بنفس الطريقة التي تقرأ بها القصص”.
وقد قرأت الكتاب، وفيه يقوم أينشتاين ورفيقه، بشرح تطور الأفكار داخل حقل الفيزياء، في الفصل الأول، يتحدث عن بداية صعود الأفكار الميكانيكية، ويتحدثون عن عبقرية جاليليو، في مخالفة المنطق البديهي للتفكير، والذي سيرى في حقيقة أن سرعة شئ ما، حجر مثلًا، ترتبط بحجم القوة التي أثرت عليه، وإذن بازدياد التأثير تزاداد السرعة، وتبين السرعة إذا كانت هناك قوة خارجية تؤثر على الجسم، لكن ما وجده جاليليو، أن الجسم المتحرك ، إذا لم تؤثر عليه أي قوة خارجية، فإنه سيستمر في التحرك إلى الأبد، وهو كما نعلم القانون الأول للحركة عند نيوتن. ثم يتشعبون أكثر عن الحالات المختلفة للحركة والقوة المختلفة التي تؤثر فيها، وكيف يمكن قياسها، كما يتحدثون عن نظرية تنقل الحرارة من جسم إلى آخر، وكيف يمكن تفسيرها ميكانيكيا، وبالمثل كيف يمكن تفسير حركة براون، ويخلصون إلى إن الانتصارات العظيمة، للنظرية الميكانيكية، جعلت العلماء يظنون أن كل شئ يمكن تفسيره فقط بهذه القوانين، حيث كل شئ ينتج عن علاقة بين القوة والحركة، ويمكن التنبؤ بجميع الحوادث إذا، كان لدينا كل المعطيات، والأهم بالنسبة لي، أنني وجدت الاقتباس، في الصفحة العشرين، حيث يقولون أن “معظم أفكار العلم الأساسية بسيطة في لبها، ويمكن في أغلب الأحيان التعبير عنها بلغة يفهمها الشخص العادي”، وفي الفصل الثاني، يتحدثون عن الصعوبات التي واجهتها النظرية الميكانيكية في تفسير العديد من الأشياء، مثل تفسير الكهرباء والطاقة المغناطيسية وطبيعة الضوء، والأثير، ثم في الفصل الثالث، يوضح كان اكتشاف المجال الكهرومغناطيسي، عاملًا ثوريًا في فهم الفيزياء، وكيف جاءت النسبية لتحل الإشكالات التي لم تستطع حلها النظريات السابقة، ثم في الفصل الرابع، يتحدثون عن قوانين الكم، وتفسير حركة الالكترونات، والطبيعة الثنائية للضوء، وغير ذلك، وعن أملهم، أخيرًا، في أن يقود تطور العلم إلى حل المشاكل التي يقف عندها.
لا أستطيع تلخيص الكتاب بالطبع، ولا أظن يمكنني ذلك، وقد فهمت كاتب مجلة نيتشر، حين قال أن القارئ سيشعر أن هناك شيئًا ما مفقودًا، وبدا لي هذا الفقد، مفهومًا، باعتبار أن الكاتبين تخليا عن استخدام أي معادلات رياضية أو تعبيرات علمية معقدة، للتبسيط على القارئ وإذن هناك “مفقود أول”، تم فقدانه بإرادة الكاتبين، ثم هناك “مفقود ثان” الناتج عن عدم استيعابي للكثير من النظريات التي حاولوا شرحها.
قرأت الكتاب، وفي ذهني، أنني “أنا الطفل الذي لم يحاوره أينشتاين”، والطفولة هنا، ستعني ضمنيًا حداثة وجودي داخل هذا المجال الذي يتحدثون فيه. وبدا لي التحوير الذي حدث للجملة مفهومًا مجازيًا، لكني قررت البحث مرة أخرى، فوجدت من يحيلني إلى كتاب عالم الفيزياء لويس دي بروي، “New perspectives in physics”، أو “آفاق جديدة في الفيزياء”، وبالتحديد إلى الفصل الحادي عشر من الكتاب، حيث يتحدث الكاتب، الحائز على نوبل في الفيزياء، عن لقائه مع أينشتاين، يحكي الكاتب عن كيف كان أينشتاين مثاله الدائم، منذ دخوله إلى هذا المجال، وكيف كان أينشتاين ونظرياته موجودين دائمًا معه في أثناء تطوره العلمي، ثم يتحدث عن دعوته إلى مؤتمر العلمي، حيث أحد المدعوين الآخرين هو أينشتاين نفسه، وأمله ألا يعود خائب الأمل، حين يلتقي أخيرًا بمثاله، وبالفعل يتحقق أمله، ويخوض حوارات علمية وشخصية مع الرجل الذي طالما أعجب به، وتبهره طباع الرجل الشخصية البسيطة والمتواضعة، ثم يتحدث عن اختلاف أينشتاين مع العلماء الآخرين في تفسيرات ميكانيكا الكم، ويخوض مع أينشتاين محادثة بهذا الخصوص، ليقول له أينشتاين إن “جميع النظريات الفيزيائية، إذا وضعنا الرياضيات جانبًا، عليها أن تعبر عن نفسها بشكل بسيط “حتى أن طفلًا يقدر أن يفهمها”.
إذن كان هناك “طفلًا لغويًا” فعلا، هذه النتيجة قد تبدو محبطة لأول وهلة، وتخالف تغييري لقناعاتي أن أينشتاين لم يقصد ذلك حرفيًا، لكن بوضع الأمور في سياقها، فأينشتاين كان يتحدث مع فيزيائي حائز على نوبل، عن خلاف، لا أفهمه كاملًا، مع فيزيائيين آخرين أغلبهم حائزون على نوبل كذلك، وفي هذا السياق، أتى الطفل، ليكون حجة أينشتاين ضد التعقيدات التي تفترضها التفسيرات الأخرى. وإذا لم تتغير قناعتي مرة أخرى، لأن الرجل بالفعل حين حاول شرح الفيزياء، وجده نفسه، يبدأ مع قارئ متعلم صبور، من بداية تجارب جاليلو في الحركة. أي من تاريخ النقاشات داخل هذا المجال، ليكون الأخير منها مفهومًا.
خطوة وخطوة
لقد ارتحت للتفسير الأخير، بما هو فهمي لجملة أينشتاين*. وإذا عدنا لمسألة الكاتب والقارئ، فأينشتاين قد خطى خطوة نحو القارئ، حين تخلى عن استخدام الرياضيات، آملًا أن هذا التخلي الضروري، سيجعل القارئ يفهم “شيئًا ما” من أسباب نشوء وتغير النظريات العلمية، دون أن يفزع من الرياضيات والمصطلحات الفيزيائية التقنية. ولكنه، على ذلك، لم يحسب حسابًا لطبيعة القارئ، الذي هو أنا في هذه الحالة، فهو يستطرد كثيرًا في التصوير النظري لتجارب علمية كثيرة، وكان سهلًا علي أن أفهم كلامه عن تلك التجارب التي أعرفها بالفعل، بينما تطلب مني الأمر، البحث، عدة مرات، عن فيديوهات تشرح تجارب أخرى، ليكون ممكنًا علي تصورها، وربما يرتبط هذا، بأنني مثلًا، شخص يتوه في التفاصيل البصرية المعبر عنها بالكلام، وهو ما يجعلني، حتى أثناء قراءة الروايات، حين يستفيض الكاتب، في تشكيل غرفة ما، بصريًا بكل دقة، تقفز عيني على أغلب التفاصيل، لتصل إلى بداية الحوار، ثم أجدني لا أفهم شيئًا فأعود مرة أخرى، مجبرًا نفسي على قراءة هذا الشئ الممل، الذي لا أستوعبه بسهولة. وإذا قلنا، أن أينشتاين، قد خطا خطوة نحوي ليفهمني شيئًا ما، فأنا أيضًا، خطوت خطوة تجاهه لأفهم. وقد لا تكون النتيجة مرضية أو دقيقة بشكل كامل، لكنها، على نقصانها، لم تكن ممكنة دون هذا الخطو المتبادل تجاه الآخر، دون أن يحاول كل منا، فعل أقصى ما بإمكانه، هو ليشرح نظريته، ملغيًا جانبًا رئيسيًا منها، وأنا أولًا لأفهم لماذا قال المقولة المنسوبة إليه، وهو الأمر الذي لم يتطلب سوى بحث بسيط وأولي تمامًَا على جوجل، وثانيًا، لأفهم هذا الشئ الذي يحاول تفهيمه لي بطريقة غير مناسبة تمامًا لتشتتي في التصويرات البصرية.
لكن هل أنا الآن أفهم النقاش الذي ضمنه، تجئ النظرية النسبية، ليس تمامًا، إنني أفهم شيئًا ما من هذا النقاش، وأعرف أنني لأفهمه فعلًا، ينبغي علي أن أقطع خطوة أكبر، وأن أدرس الشئ نفسه، بكل تعبيراته، الرياضية والفيزيائية المعقدة. فليس هناك طريقة بسيطة، أو “لايف هاك”، للدخول إلى مجال ما. إنه لا يمكنه سوى رسم خريطة شبحية، لا يمكنني تخيلها، دون الدخول فيها.
يشبه الأمر أن تحضر فجأة، إلى مكان اجتماع ما، هذا الاجتماع مستمر منذ ألف عام، وفجأة تطلب من أحد الحاضرين، أن يلخص لك بالضبط، ما تناقشوا فيه وما توصلوا إليه، هذه الغربة الحتمية، لا سبيل سهل لإنقاصها، فالآتي على نقاش فلسفي، ويحب أن يفهمه، عليه أن يقرأ طويلًا ويتناقش طويلًا، حتى يصبح هذا النقاش، في بعض جوانبه مفهومًا له، ويصدق ذلك على أغلب حديثنا.
هذه الخطوة التي نقطعها، هي ما تعطينا، في رأيي، هذا الإحساس المزيف بالمعرفة بمجرد امتلاك كتاب ما، نشعر، ربما بشكل لاوعي، أننا قد قطعنا خطوة، وأنه على الأقل، أصبح لدينا الآن، خريطة للمعرفة، لا تحتاج إلا أن نفتحها. وفي الأغلب، تتكون معارفنا غير المتخصصة، من خرائط شبحية لأماكن مجهولة، نعرف بعض الأسماء والمصطلحات، ونعرف كذلك، أنه ينبغي علينا، للتخلص من هذه الشبحية، أن نسير، في لحظة ما، إلى هذه الأماكن المجهولة.
من هذا القادم؟
لابد، أنك مثلي، تعرف أن هناك اتجاه في النقد الأدبي، يرى أنه لا يمكن أبدًا التوصل إلى معنى نهائي ل”كتاب ما”، لأن الكتب والمعارف والنقاشات التي يستحضرها كل قارئ معه، تختلف بالضرورة، في بعض مكوناتها على الأقل، مع تلك التي يستحضرها الكاتب. كما أن “الحالة النفسية والشعورية” للقارئ تختلف بالتأكيد عن تلك كان فيها الكاتب لحظة كتابته. وإذا مددنا الخط على استقامته، يمكن القول أن فهم أحدنا للآخر، يبدو شيئًا مستحيلًا، لأن لكل منا دائمًا معارفه وتكوينه وتخيلاته البصرية للكلام، المختلفة عن الآخر.
لكنني، أتخيل، أن كثيرين مثلي، وجدوا الفكرة السابقة مربكة، وهي مربكة، في رأيي، لأنها تختلف مع شئ نعرفه، شئ اختبرناه في حياتنا، هذا الشئ، في حالتي، هو أن اختبرت شعور أن أكون مفهومًا، و سبق لي، أن فهمني أصدقاء دون حتى أن أتكلم. وأعرف، أنهم لكي يفهموني، كان عليهم، أن يقطعوا خطوة ما تجاهي، وأن يتجاوزا اللحظة التي بدوت فيها غير مفهومًا تمامًا للآخرين. ليستمروا في قراءتي آملين بأنه في لحظة ستكون تصرفاتي مفهومة.
هذه الخطوات هي ما نملكه لنفهم الآخرين، دون نتيجة أكيدة، ومعلوم أن الأدب، يستخدم تقنيات بلاغية عديدة، لإيصال شعور ما، لا يمكن إيصاله، بالكلام العادي، فتكون المجازات والتشبيهات والتقديم والتأخير والحذف، كل هذا المجهود، آملين أن قارئًا ما، سيخطو هو الآخر خطوة تجاههم، ويبحث عن أسباب تكوين الجملة بهذا الشكل دون غيره، وعن معاني الكلمات التي ربما تصبح في زمن القارئ غير مألوفة، بهذا المعنى، أفهم أن القارئ يغير من معنى الكتاب الذي يقرأه، لأن القراءة نفسها، تتطلب منه، أن يخطو خطوة إضافية تجاه هذا القادم.
___
*بعد أن أرسلت نسخة هذا المقال الأولى، للمحرر، وبينما أراجعه مرة ثانية، فكرت لماذا قلت “بمجرد البحث بالانجليزية”، وليس “بمجرد البحث”، وفكرت أن هذا ربما كان ليمكن للقارئ أن يتتبع ما فعلته بالضبط، ليصل إلى ما وصلت إليه، بعد عدة دقائق، لكن هذا قد يفهم أن هناك جملة محذوفة، مضمرة، من الكلام وهي “أنني بحثت بالعربية ولم أجد أشيئًا ، ثُم”بمجرد البحث بالانجليزية”، وأن علي أي أزيل سوء التفاهم هذا قبل حدوثه، وفكرت أنني هكذا لم أبحث بالعربية، وهناك احتمال كبير أن يكون أحدهم قد راوده نفس التساؤل، فبحثت بالعربية، لأجد مقالًا لشادي عبدالحافظ، يحاول فيه تفسير المقولات المنتشرة لأينشتاين، والتي هي في أغلبها، غير دقيقة، لأسباب يحاول شادي شرحها بشرح كيفية تحويل أينشتاين كأسطورة، حتى أن هناك شائعة منتشرة تقول إن “عشرة في العالم فقط من يستطيعون فهم نظريته”، ويقول شادي إن أينشتاين نفسه، تلقى هذا السؤال، وأجاب عليه بأن “في كل مرة أذهب فيها إلى أي مكان يسألني أحدهم في هذا الموضوع”، ثم يستكمل: “وهذا سخيف. يمكن لأي شخص لديه تدريب كاف في العلوم أن يفهم النظرية بسهولة، ولا يوجد شيء مدهش أو غامض حول هذا الموضوع، من السهل جدا أن تتدرب عقول الطلبة على هذا النمط من الفيزياء، وهناك الكثير من هذه الأمور في الولايات المتحدة”. ويحيل شادي إلى كتاب “أينشتاين يلتقي أميركا” في صفحة 147، حيث وجدت الاقتباس موجودًا ودقيقًا بالفعل. وهو يستقيم مع ما فهمي لمقولة أينشتاين التي بحثت في تفسيرها.