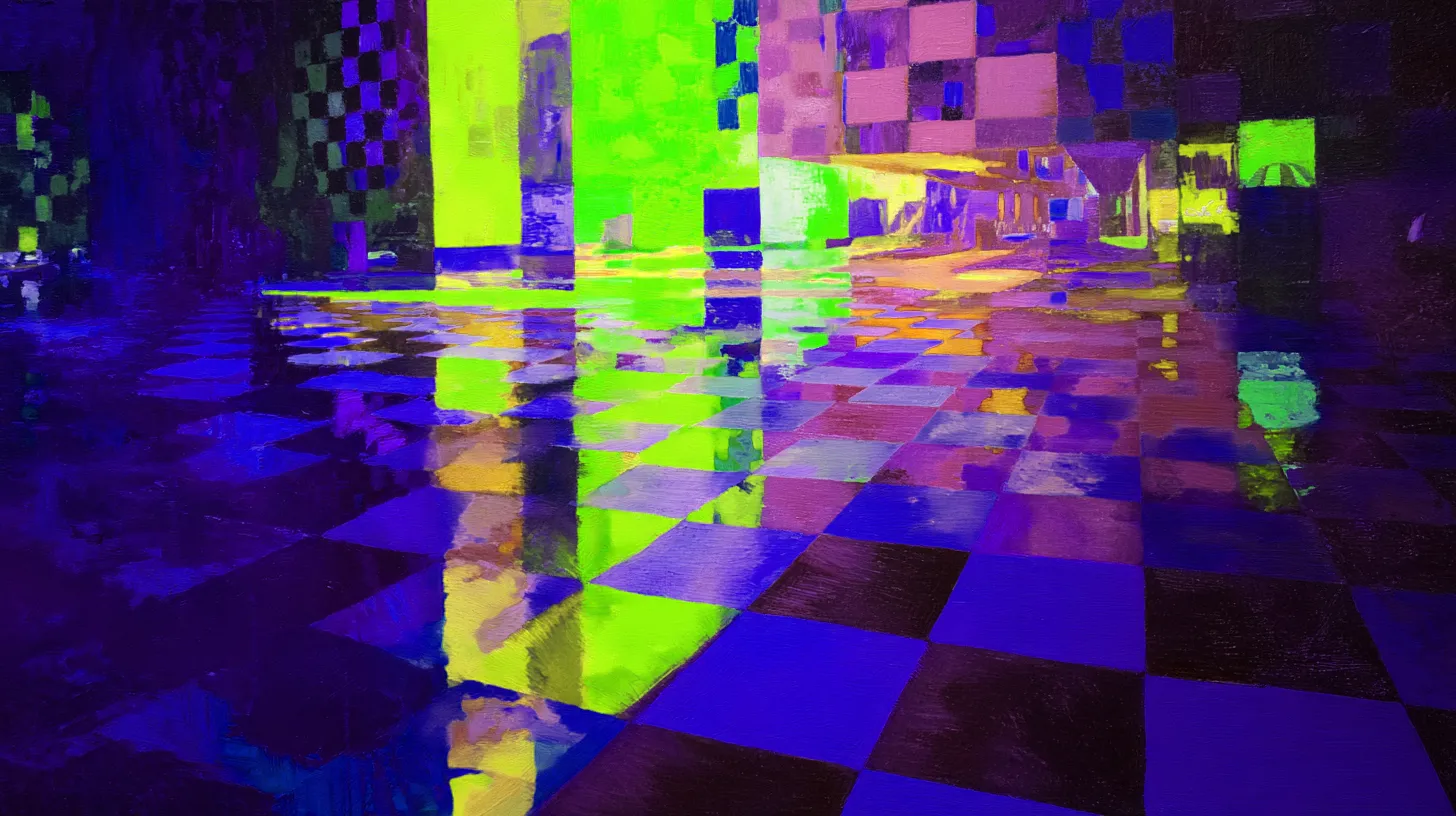إذا شاهدت لاعب كرة سابق، عُرف بمهاراته، يلعب مباراة خيرية، أو يستعرض مهاراته في قناة تسجل وثائقيًا عنه، ربما، مثلي، سيداخلك ارتياح ما، حين يتمكن هذا الرجل، الذي لم يعد رياضيًا أبدًا، من التحكم والتلاعب بالكرة بسلاسة تذكرك لوهلة بما كانه يومًا ما، ارتياح أن ما كانه هذا الرجل، مازال بداخله، وتقول: “إن دبل الورد.. ريحته فيه”.
في عالم المثل، هناك “جوهر” ما، لا يمكن فقدانه، حتى وإن اختفى ذلك الجوهر، أو احتجب، يبقى هناك. ولهذا فالمثل لا يقول ما يقوله مثل آخر وهو “يموت الزمار وايده بتلعب”، في المثل الأخير، لم تتوقف يد الزمار أبدًا عن اللعب، جوهر الزمار لم يتعرض أبدًا للتشكيك، فهو زمار في الماضي والحاضر والمستقبل، وبالتالي فمثل الزمار يفترض استمرارية معلنة وواضحة، لم يخش فقدانها، بينما يأتي مثل الوردة، ليفترض استمرارية غامضة، أو مختفية، استمرارية جوهر، لم يعد، فقط، وجوده في الحاضر مناط التساؤل، بل هذا التشكيك في حاضره، ربما يمتد لوجود جوهره حتى في الماضي. تشكيك يمكن إعلان بطلانه، بدليل مادي، فإذا كانت الرائحة الجميلة حاضرة في الوردة الذابلة، فكيف بها قبل ذلك؟
قريبًا من ذلك أغنية “ياماما ستو”، كلمات صلاح جاهين، وغناء فرقة المصريين، في الأغنية تحكي الجدة لأحفادها حكاية:
“كان فيه بنوتة، حلوة وكتكوتة، واقفة مكبوتة شاعرة بالنقص، قال إيه يا إخواتي، لا ابن الساعاتي، ولا ابن الحاتي طلبوها للرقص”،
فيتشكك أحفادها: “ياماما ستو، بلاش تهويش، أيامكوا كان فيه رقص كمان؟”، فترد الجدة بالدليل: “طب حزموني وسكوا الشيش واتفرجوا على رقص زمان”. كاللاعب الذي سيطلب منك الكرة ليثبت مهاراته السابقة، هو لا يريك مهارته السابقة، إذ يعلم كليكما استحالة ذلك، هو بالتحديد يريك شبحها، بالضبط كما لن ينتظر الأحفاد من جدتهم رقصًا متناغمًا سلسًا، بل طيف هذا الرقص.
افتراض الجوهر الكامن، الذي لا يمكن فقدانه، هو بالضبط ما حاول الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، المحاججة ضده، في محاضرته الشهيرة “الوجودية مذهب إنساني”، حين لخص مذهبه في أن “الوجود يسبق الماهية”، أي أن وجود الإنسان يأتي أولًا، ثم يصنع الإنسان “ماهِيته” بالتفاعل مع الخيارات التي يجدها أمامه. عند سارتر ليس فقط لا يوجد جوهر لا يمكن فقدانه، بل لا يوجد هذا الجوهر ابتداءً، ومادام لا يوجد جوهر، فـ**”جوهر الإنسان”**، أي ماهيته، هي نتاج اختياراته في الحياة، ولا يمكن الحكم على ذلك الإنسان سوى بعمله، وليس بإمكاناته القَبْلية.
بالنسبة لسارتر، الإنسان ليس إلا مشروع الوجود الذي ينخرط فيه، ليس إلا مجموع أفعاله. وبحد تعبيره، فالعبقرية “هي عبقرية تعبير العبقرية عن ذاتها، في المنتجات الحية التي تطالع بها العالم، فعبقرية مارسيل بروست مثلًا هي مجموع مؤلفاته، وعبقرية راسين هي مجموع مسرحياته. لا شيء من عبقريتهما ليس إلا ما كتباه. أما القول بأن راسين كان من الممكن أن يكتب مسرحية لم يكتبها، فقول لا معنى له، لأنه لو كان يستطيع كتابتها فلِمَ لم يكتبها؟”
وقد يمكن الجمع بين سارتر والمثل، بأن نقول إن جوهر اللاعب المهاري لم يُفقد، ليس لأن اللاعب وُلد به مسبقًا، بل لأنه حققه بالفعل، وفقط حينما تحقق هذا الجوهر، أصبح غير قادر على الفقدان. وقد يُقال إن الجوهر أصبح غير قابل للفقدان، لا لأنه بمجرد تحققه أصبح أبديًا، بل لأن اللاعب حريص على ذلك، حريص على أن يظل يمتلك دليلًا على جوهره القديم. لكن هناك اعتراض وجيه، ناتج عن سوء اختياري للمثل، فقد يُقال إن مهارة اللاعب التي لم تختفِ، ليست جوهرًا بالمعنى الفلسفي، إنها ذاكرة عصبية، بالضبط كما لا ننسى كيفية قيادة الدراجة، مهما امتد الزمن بين فترات ممارستها. وإذن لنختر مثالًا آخر.
في فيلم “الأسد الملك”، يغادر سيمبا موطنه بعد مقتل والده الملك موفاسا على يد سكار، أخ موفاسا وعم سيمبا، ونجاح سكار في إقناع سيمبا بمسؤوليته عن الحادثة. يعيش سيمبا حياة من الدعة والصعلكة مع تيمون وبومبا، شعارها الاستمتاع باللحظة، بينما يصعد سكار إلى العرش الذي كان من حق سيمبا. يكبر سيمبا صعلوكًا، دون أن يمتلك ظاهريًا أية من صفات والده، ثم يلتقي بصديقة طفولته نالا صدفة، وترجوه نالا أن يعود لاسترداد مملكته، يتهرب منها، لكنها توقظ شيئًا بداخله يجعله يطلب المشورة من والده الميت، فيتدخل القرد الحكيم ويجعله ينظر في المياه حيث يرى وجه أبيه، ثم يأتيه أبوه من السماء بمشورة بسيطة: “تذكّر انتَ مين”. هكذا، بهذه البساطة، بمجرد أن يتذكر سيمبا جوهره الحقيقي، يتحقق هذا الجوهر، فور تذكره يعلم سيمبا ما عليه فعله، ويصير الشاب الصعلوك المدلل، ما كانه منذ القدم، “الملك الحقيقي”، ويعود ويسترد مملكته.
مكانة سيمبا داخل “دائرة الحياة” محفوظة، وجوهره دائم، قد يتغافل عنه أو ينساه، لكنه لا يفقده. جوهر لا يحتاج أن يكتسبه أو يصنعه، وتكفيه نكزة من الحياة لتُخرجه من الإمكان إلى الواقع.
صحيح، قد يقول سارتر إن سيمبا اختار أن يتذكر في النهاية، واختار أن يعود، وهو ما أكسبه جوهره، لا أن هذا الجوهر كان هناك دائمًا، بل خرج للحياة أول مرة لحظة أن اختار سيمبا أن يتذكر. فهو في النهاية، لم يصبح ملكًا إلا بعد أن اجتاز الصحاري وعاد لموطنه وحارب عمه وانتصر عليه. وفي أي لحظة قبل هذا التحقق الكامل لمشروع “سيمبا الملك”، لم يكن هذا الجوهر موجودًا. وقد يضيف إنني اخترت مثالًا آمنًا، إذ نعرف من الفيلم مسبقًا، أن سيمبا أصبح ملكًا، ولهذا نفترض أن “تذكره” وحده كان كافيًا تمامًا، ففي مسارات أخرى للحكاية، قد يظل سيمبا يتهرب من نالا للأبد، أو يعود، تحت الضغط الاجتماعي، لأرضه ويخسر المعركة. وحينها سيكون منطقيًا أن نقول إن صعلكته الطويلة أطفأت تمامًا اتقاد “جوهره الملكي”.
لكن قد يُرَد على هذا الكلام، أن سيمبا لم يختر التذكر إلا لاقتناعه المسبق، والخفي، أنه “الملك”. هذا الاقتناع نفسه، يمكن المحاججة أنه نتاج لتشرّب الثقافة المجتمعية المحيطة به منذ طفولته، وإذن قد نرده لاختياره أن يجاري الضغط المجتمعي عليه.
في الجزء الثاني من الفيلم، حيث يكون سيمبا هو الملك، نلحظ شرخًا بسيطًا في “جوهر الملك سيمبا”، فرغم أنه يظل ملكًا مهيبًا كوالده، إلا أنه يتردد أكثر، ويحاول التفكير فيما كان والده سيفعله لو كان مكانه (في المقابل، لم نلحظ على موفاسا أي ارتباك، كان دائمًا في المكان الصحيح يعلم ما عليه فعله). وفي لحظة ما تصرخ فيه ابنته: “عمرك ما هتبقى موفاسا”، ويمكننا أن نفسر ذلك، بأن سيمبا لا يمكنه استعادة جوهره الملكي كاملًا بعد صعلكته الطويلة، كأن سيمبا الصعلوك المغترب عن جوهره يظل موجودًا داخل سيمبا الملك، كما كان سيمبا الملك حاضرًا داخل سيمبا الصعلوك. وهناك تفسير سارتري مغاير لمقولة ابنته، فقد يُقصد بها أن على سيمبا الملك، أن يكون مخلصًا لجوهره هو الملكي، لا جوهر والده، أن يكف عن محاولة التطابق مع المثال (مع ما تعنيه محاولة التطابق من إزاحة المسؤولية إلى المثال) ويتحمل مسؤولية قراراته.
في عالم المثل، نحتفظ بأطياف إمكاناتنا غير المحققة، كأن كل عالم بديل لم ندخله، يترك تذكارًا في عالمنا الحقيقي. هكذا نكون مجموع عوالمنا الممكنة والمحققة، لا عوالمنا المحققة فقط كما قد يقول سارتر. وربما يبدو هذا القول شاعريًا بدرجة ما، لكننا نستخدمه في حياتنا اليومية، حين نحكم على فرد ما في عالمه الحالي، بأنه ما زال يحمل بصمات عالم آخر كان ممكنًا، كـالشاعر الذي أصبح روائيًا، ونرى أن لغته ما زال بها ذلك الحس الموسيقي، أو الأديب الذي أصبح طبيبًا وما يزال يجرب خفية كتابة القصص، أو الفيلسوف الذي أصبح رجل أعمال وما زال يبحث عن المعنى الكلي حتى في نطاق عمله الضيق، أو الشاعر الذي أصبح محاميًا، وتفلت منه أثناء حديثه تعبيرات شديدة الشاعرية، وعالم النفس الذي صار مهندسًا ويشغل نفسه بتحليل شخصيات زملائه… وأمثلة أخرى بلا نهاية، تخبرنا أنه لا وجود لذلك “التحقق المعياري” لجوهر ما، الطبيب الذي هو طبيب فقط، والمهندس الذي هو مهندس فقط، والمحامي الذي هو محامي فقط، كل منهم لا يحقق أبدًا “جوهرًا” واحدًا، بل يسير داخل عالم واحد، بينما تفوح منه رائحة كل تلك العوالم البديلة.