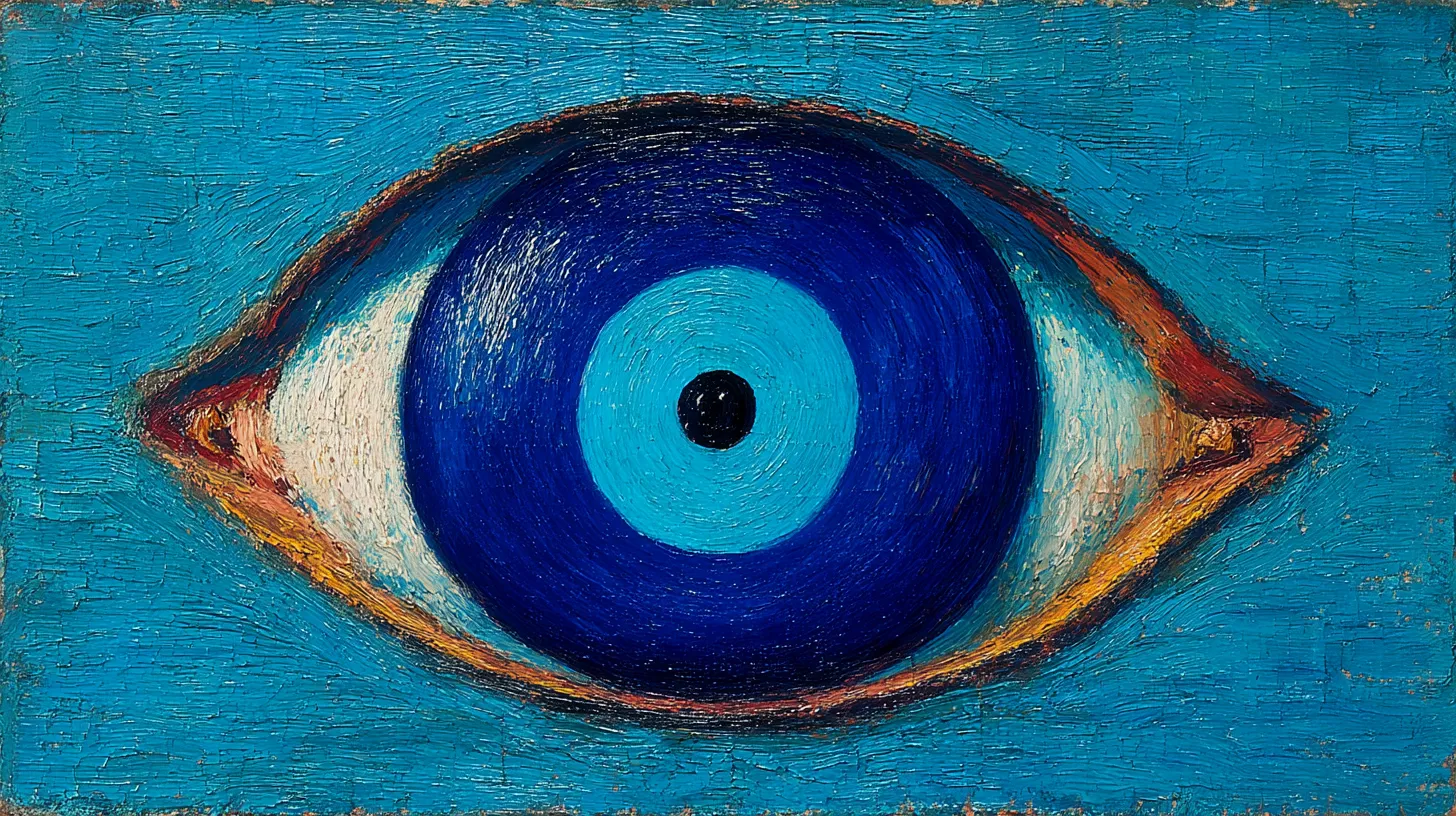داخل مقهى صغير يطل على إحدى الأزقة المنسية في رواية الكاتب الياباني توشيكازو كواغاوشي “قبل أن تبرد القهوة”، كان هناك مقعد منزوي في ركن جانبي أشيع أنه يتيح للجالسين العودة بالزمن، بشروط محددة، منها قبل أن تفتر أقداح قهوتهم. تتعلق أعين بعض الزائرين في ترقب لفروغ ذلك المقعد، أملاً في الارتداد إلى لحظة مفصلية من حيواتهم يعجزون عن تخطيها، لعلهم بذلك الكرسي يجدون خلاصاً من الماضي بالبوح بما استعصى عليهم في مرحلة ما، متمسكين بحبل واهٍ وإن بدا بلا جدوى.
يشبه شعر الهايكو في اليابانية الجلوس على ذلك المقعد والعجز عن صياغة حقيقة مشاعرنا ببساطة، مؤثرين الإيجاز أحياناً، والتحديق في كوبك على أمل أن تلمح انعكاساً قديماً لقسمات أذابها الحنين وترسبت في قاع الفنجان والقلب، لتجرفها عبارتين أو ثلاث من الشعر مشكلة قصيدة كاملة، أقرب لموجة خاطفة تحاول اللحاق بتلك اللحظة التي سقطت من حسابات العالم. يوجز الشاعر الياباني ماتسو باشو في قصيدته “بركة قديمة” تلك الدقيقة الحاسمة من الصمت الأبدي حين يخط: على ضفاف بحيرة قديمة، قفز ضفدع، خارقاً سكون المياه، ليخبو في اقتضاب هذا الشعر تلال من التفاصيل داخل كل منا.
عتبات الألم في لوحة “عند بوابة الخلود” للفنان الهولندي فان جوخ يتعاظم فيها حجم الرجل الكهل مقارنة بما حوله، جالساً بلون ثيابه الأزرق البارد المتعارض مع لهيب المدفأة، عاكسا لون الحزن بانكبابه على كرسي خشبي مائل بجذعه إلى الأمام، خافياً وجهه بكفيه، بادياً عليه الهم.
لوحة عتبات الخلود، فان جوخ
تصور اللوحة ومشهد ماتسو الشاعري، والشخوص التي تتوالى في رواية توشيكازو ما يورثه الكتمان من ندم دفين وغضب قد يتفجر كلما بلغ ذروته، ليحدثنا المختصون النفسيون عن ضرورة الإفصاح والانفتاح على دواخلنا، ويسرد الطبيب النفسي برنارد جولدن بعد عصارة 40 عامًا من الاحتكاك بالبشر جانبًا من سر عجزنا عن ذلك بيسر؛ يتمثل في كوننا لا يسعنا إدراك ما يخالجنا بدقة، فلا يكفي إدراك انزعاجنا من أمر بعينه، بقدر ما ينبغي علينا التريث لوهلة ومحاولة تفكيك عمق تلك العاطفة، أهي نابعة من السخط أم الرفض أم الخجل؟ فالوعي بذلك يضفي عليها وضوحًا ويجعلنا أكثر صدقًا مع أنفسنا ومع الآخرين. يحثنا جولدن بعد ذلك على التفكر فيمن نبوح له وسبب رغبتنا في المشاركة من الأساس، أهي المشورة أم التنفيس أم اكتشاف الذات؟ وماهية توقعاتنا؟
الحنين إلى زمن آخر
تشبثت بطلة رواية توشيكازو “فوميكو” بيأس برغبتها في مصارحة الرجل الذي أحبته حين كاد يهم بالرحيل إلى أمريكا بأن يبقى، ودت لو تسنّى لهما الجلوس مجددًا في ذلك المقهى النائي وتنقشع عنها غمامة الغضب، وتنصت له وتحدثه عمّا يراودها، لعل شيئًا ما من حاضرها يتبدل.
ربما ما أعاق فوميكو عن النطق بتلك الكلمات، هو ما يمسنا على حد سواء باختلاف السياقات، كما تخبرنا المعالجة النفسية كولين مولين، من خوف يتصل بإظهار ضعفنا وهشاشتنا، هذا الانكشاف الذي يحمل في طياته مجازفة كالخذلان، فنعمد إلى الكتمان لما يمنحنا من إحساس زائف بالأمان. ناهيك عن القلق الذي قد يحاوطنا من أحكام الآخرين أو أن نبدو كثيري الشكوى أو مخافة التصادم مع من نحب، وأحيانًا لأسباب خاصة بالثقة، كخيانة أحدهم لنا وكشف ما ائتمناه، أو العجز عن التعبير، أو عدم التيقن مما نشعر، أو انعدام ثقتنا في ذواتنا، كأن نشعر منذ الصغر بأن آراءنا ومشاعرنا لا تُنظر بعين الاكتراث أو نتلقى توبيخًا عليها فنتعود على إخفائها تلافيا لأي انتقاد.
إذ رأى مختصون نفسيون من جامعة إلينوي أن خلفياتنا الثقافية والاجتماعية تلعب دورًا في تعاطينا مع الأحداث وتفسيرها، بل وطرقنا في التعبير عن عواطفنا، إذ نتلقن ذلك منذ الطفولة. نلتقط على سبيل المثال من الصمت العقابي الذي قد يعتمده أحد الوالدين في التعبير عن غضبه، أو الصراخ بكلمة مثل “لا ترفع صوتك في وجهي” قاعدة نتحصن بها من إبداء انفعالاتنا. لنشب مكتسبين صفات منها: تعاملنا دائمًا مع مشاعر الآخرين على أنها أكثر أهمية من مشاعرنا، متحاشيين الدخول في صراعات أو التسبب بمشاعر سلبية لشخص آخر، وعدم إيلاء أحاسيسنا الاهتمام الكافي، واجتناب التعبير عن الغضب وتلبسه فقط عند جذب الانتباه، علاوة على ذلك، عدم الثقة بالآخرين حينما يتعلق الأمر بمشاعرك، والاحتكام إلى المنطق حصرًا، وإبداء سعادتنا مهما حدث.
تخبر إحدى العاملات في المقهى فوميكو بأن العودة إلى ما انقضى لن يحل شيئًا مما هو آت، ترفض فوميكو مواجهة تلك الحقيقة، عاقدة آمالًا على خرق القواعد بل والزواج من حبيبها، لكنها حين تعود ويتكاشفان للمرة الأولى من مسافة أبعد، تكتسب الأمور منظورًا أشد منطقية، تتبخر على إثرها أوهامها للمرة الأولى والأخيرة، وتدعه يرحل مدركة بأن المخاوف كانت قائمة في علاقتهما كحاجز من زجاج.
هكذا توصينا عالمة النفس سوزان هيتلر بقبول كل ما نشعر به بداية، والكف عن التنصل منه، وامتلاك مفردات للشعور والانتباه لها، لنبدأ عباراتنا بضمير المتكلم عوضًا عن المخاطب الذي يحمل بعض الاتهام ويجعل من أمامنا يتخذ موقفًا دفاعيًا، يكفي أن نقول ببساطة “أنا أشعر…” متبوعة بإحساس لا فكرة أو انطباع لاستدرار التعاطف، وأن نكون واضحين بذكر مصدر الأزمة، كقول “شعرت بالضيق حينما لم أتلقّ ردًا منك حيال…”.
تشدد سوزان على انتقائنا لكلماتنا بعناية واستبدال كلمة غضب بإحباط، والانتباه لنبرة صوتنا، بتخفيضها ومحاولة التحلي بالهدوء ولو نسبيًا قبل المصارحة، كما تشير لحتمية تشريح العاطفة التي توصلنا إليها بالغرق في التأمل والتساؤل مليًا أو الكتابة، وبعد ذلك مشاركتها لأحد المقرّبين والتعلّم عن الذكاء العاطفي.
أنقذتني تلك النصيحة قبل عدة سنوات، حينما وجدتني عالقة في أحد المواقف الشائكة، سألت صديقتي النصح، فأخبرتني بإحدى المساقات المتمحورة حول ذلك النمط من الذكاء، عكفت على دراسته، لأجدني أرسم لذاتي خريطة للخروج من ذلك المأزق، واكتسبت نظرتي شيئًا من الوضوح أقرب لما اختبرته فوميكو.
كانت فوميكو واحدة من عدة شخصيات سيّرها توشيكازو لخدمة ثيمة روايته، وحلّ تعلق كل منهم بما كان لهم أن يقولوه لأحبائهم، ليشبهوا بطل لوحة فان جوخ، لتمثل نصيحة هؤلاء المختصين منفذًا للانفتاح على التعبير عن ذواتنا ومشاعرنا، والاستغناء عن كل ما هو مبهم وإن بدت غوايته منفتحة على عدد لا نهائي من الاحتمالات.