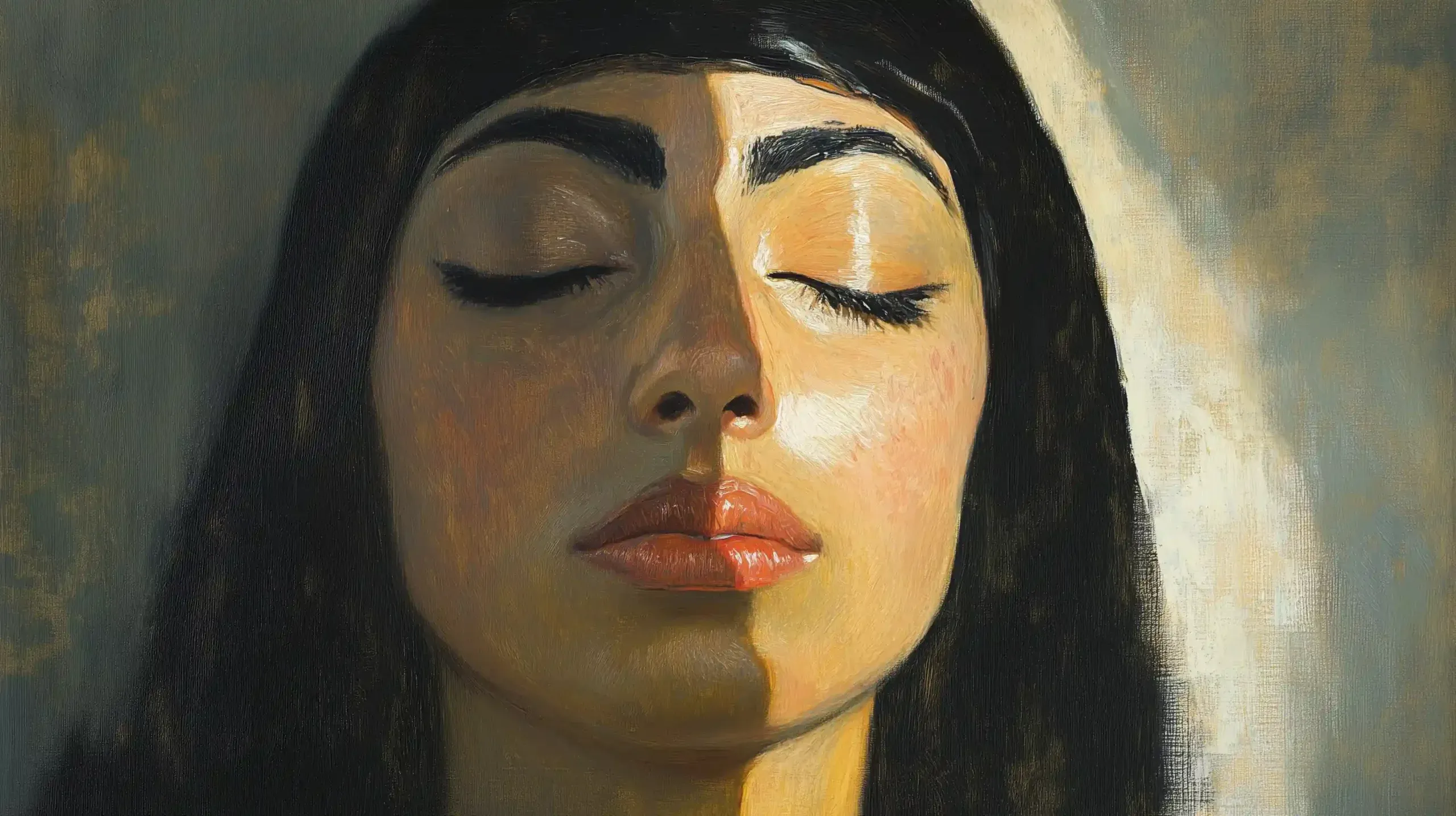قديمًا، لم تكن الأمراض النفسية تحظى بنفس الاهتمام الذي تحظى به اليوم، إذ إن غالبًا ما كان يوصم ضحاياها بالجنون، أو حتى بالمس الشيطاني، إلا أن ذلك تغيّر بشكل كبير في العصر الحديث، ذلك التغيُّر يرجع إلى التقدم الكبير الذي شهده مضمار البحث العلمي في مجال الطب النفسي.
لكن هذا السبب وإن كان محوريًا، فهو لا يعد السبب الوحيد، فتحديات المجتمع الحديث فرضت على الإنسان أن يهتم بالمشكلات التي باتت تمثل عائقًا كبيرًا أمام راحته وسعادته، بل وحتى وجوده، وكان من بين أهمها الأمراض النفسية.
من بين أبرز الأمراض والمشكلات النفسية التي واجهت إنسان العصر الحديث، برغم تنوعها الكبير، كان القلق في المركز، حيث قدّرت منظمة الصحة العالمية في آخر إحصائياتها أن هناك أكثر من 300 مليون إنسان يعاني من القلق بشكل مرضي حول العالم، ما يجعل القلق هو أكثر الأمراض النفسية شيوعًا في العالم.
كيف بدأ القلق؟
لم يكن القلق في العصور الغابرة هو أكثر ما يؤرق الإنسان على المستوى النفسي، إذ إن طبيعة المعرفة البشرية وما أنتجته من تحديات كانت مختلفة جذريًا، فقديمًا كان الغضب هو أكثر الموضوعات النفسية التي شغلت عقل الإنسان، ذلك يرجع لارتباط الغضب بالآلهة في كثير من المجتمعات والحضارات القديمة، بل أن الغضب كان يصنّف أحيانًا على أنه خطيئة.
كما أن الغضب كان له دلالات على الجهل وقلة الحكمة، فكان من الحكمة ألا يظهر الإنسان غضبه بسهولة، والعكس صحيح، ذلك ما يظهر في كثير من آيات العهد القديم بالكتاب المقدس.
تغير ذلك كله في العصر الحديث، فحدود معرفة الإنسان بعالم الآلهة والأرواح استقرت إلى حد كبير، فبات الغضب مشكلة ثانوية، ليحل محلها القلق، الذي أصبح داء الإنسان الحديث، الإنسان الذي لم يعد يخاف من وحوش البرية، ولا من ضربات الآلهة الغاضبة، ولا من الوفاة جراء الإنفلونزا الموسمية.
أصبح الإنسان الحديث مطمئنًا على حياته بقدر لا يمكن مقارنته بإنسان العصور القديمة، لكن ذلك الاستقرار والطمأنينة دفع إلى ظهور مشكلة ترتبط بالاستقرار والطمأنينة أنفسهم، أو بتعبير أدق، بزوال الاستقرار والطمأنينة.. ألا وهو القلق.
المال أصل كل الشرور
“إن إنسان القرن العشرين قد تشيأ، أي أصبح شيئًا”
إيريك فروم
كان عالم النفس الألماني “إيريك فروم” من بين أوائل العلماء الذين حللوا طبيعة المشكلات النفسية الحديثة وعلاقتها بمحيطها الاجتماعي، وكان القلق إحدى أبرز الظواهر التي حاول تفكيكها، فقد أرجع “فروم” أسباب القلق الذي أصاب إنسان العصر الحديث إلى موقعه الجديد من عالمه.
حيث قال “فروم” إن نمط الحياة الحديثة في إطار المنظومة الاقتصادية الرأسمالية قد حول الإنسان إلى سلعة للتبادل في السوق تمامًا كأي سلعة أخرى، ذلك ما قاد الإنسان إلى الشعور بفقدان المعنى والقيمة، بالإضافة إلى انهيار سبل الحفاظ على الاستقرار والأمان المادي في ظل وتيرة التغييرات السريعة لمنظومات العمل الحديثة، وهو ما أنتج في النهاية شعورًا متزايدًا بالقلق من المجهول.
تلك الرؤية التي تُحمّل المنظومة الاقتصادية الحديثة مسؤولية المشكلات النفسية للإنسان المعاصر لم يتفق معها المنظرون الاجتماعيون فحسب، بل كثير من نوابغ القرن العشرين، على رأسهم الفيزيائي الأشهر في التاريخ “ألبرت أينشتاين”، الذي وجه هجومًا عنيفًا للرأسمالية أيضًا محملًا إياها مسؤولية القلق والاكتئاب الذي تفشى خلال العقود الأخيرة.
حيث قال “أينشتاين” في مقال كتبه لمجلة “Monthly Review” الأميركية عام 1949: “إن السعي الدائم من أجل الربح بالتزامن مع حدية المنافسة بين الرأسماليين، هو المسؤول عن غياب الاستقرار في تراكم رأس المال وآليات استخدامه، مما يتسبب في موجات من الاكتئاب. إن التنافس الذي لا يحده أي ضوابط يؤدي إلى إهدار الكثير من الطاقات والموارد في العمل، بالإضافة إلى التسبب في شلل في الوعي الاجتماعي لأفراد المجتمع”.
هنا يمكننا أن نرى ببعض من الوضوح أسباب القلق المزمن الذي أصاب الإنسان الحديث، فطبيعة المجتمع الجديدة المتمثلة في الرأسمالية الجامحة، والتي لم تكن على هذا النحو في السابق، دفعت أفراد المجتمع إلى السقوط في فخ القلق من عدم القدرة على مواكبة متطلبات الحياة اليومية.
فما الذي يضمن استقرارًا طويلًا في ظل التنافس المحموم بين البشر على مصادر الرزق؟ ذلك التنافس الذي انتقل نزولًا من مستوى الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، إلى مستوى الفرد، ليجد الإنسان نفسه في سباق بلا نهاية، سباق هدفه فقط أن يظل ثابتًا في مكانه.
الكثير من البنادول
مع تفشي القلق بين أفراد المجتمع وما يصاحبه من خلل في القدرة على تأدية المهام اليومية، بدأت تتبلور أشكال من الحلول لمساعدة الإنسان على التغلب على قلقه، ومن ثم ضمان استمراره في القيام بوظائفه بكفاءة.
تلك الحلول تمثلت في أشكال متعددة من الطقوس والممارسات والرياضات الذهنية، كان أبرزها وأكثرها تكاملًا ورواج ما يعرف باليقظة الذهنية “Mindfulness”، وهي عبارة عن ممارسات تتمحور حول الضبط النفسي للإنسان في مواجهة تقلبات الحياة اليومية من خلال أنشطة تأملية وفكرية ترتكز على رؤية الإنسان لذاته.
تنطلق ممارسات اليقظة الذهنية من حقيقة مركزية تتفرع منها كافة الأفكار الأخرى، ألا وهي أن المشكلة دائمًا تكمن داخل رؤوسنا، وليس في أي مكان آخر، ولكي نتغلب على المشكلات النفسية التي تواجهنا، علينا أن نغير طريقة تفكيرنا، وليس الواقع الذي دفع لتلك المشكلات.
ذلك الدين الجديد للرأسمالية قد لقي استحسانًا كبيرًا بين أصحاب رؤوس الأموال، لدرجة أنه دفع العديد من الشركات العالمية الكبرى لتخصيص محاضرات دورية مجانية لموظفيها لتدريبهم على ممارسة اليقظة الذهنية، كان أبرزها “جوجل” و”إنتل” و”جولدمان ساكس”.
لما لا، فاليقظة الذهنية لا تمثل أي تهديد على الأسباب الرئيسية التي أدت لمشكلات الإنسان الحديث، أي المنظومة الاقتصادية، بل على العكس تمامًا، إذ إنها حمّلت الإنسان المغلوب على أمره مسؤولية معاناته، ولكنها برفق خبيث قدمت له حلولًا أشبه بالمسكنات التي ستساعده حتمًا على تحمل الألم، ولكنها لن تقدم أي حلول من شأنها معالجة المرض من جذوره.
هل يمكننا هزيمة القلق؟
“إذا كان القرن الـ17 هو قرن الرياضيات، والقرن الـ18 هو قرن الفيزياء، والقرن الـ19 هو قرن البيولوجيا، فإن القرن العشرين هو قرن الخوف”
ألبير كامو
حاول الفيلسوف الفرنسي “ألبير كامو” في أشهر كتبه “أسطورة سيزيف” أن يُشرّح مشكلة الإنسان المعاصر المتمثلة في أفول عصر السرديات الكبرى، الذي كان نتيجة لصعود النظم الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، ما دفع إلى شعور متزايد بالعدمية وفقدان المعنى، وكان ثمرته القلق العالمي.
وقد وضع “كامو” أسطورة سيزيف الشهيرة من الميثولوجيا اليونانية مرادفًا لمعاناة الإنسان المعاصر، تلك الأسطورة التي تروي أن كبير الآلهة اليونانية “زيوس” عاقب التاجر الجشع “سيزيف” بأن يحمل صخرة من أسفل جبل إلى أعلاه، وعند وصوله للقمة تعود الصخرة مجددًا للوادي، فيرفعها مرة أخرى للقمة، وهكذا إلى الأبد.
تلك الصخرة التي لم يعد يراها الإنسان المعاصر، أو ربما ما هو أسوأ من ذلك، لعلنا أحببنا صخرتنا المعلقة في رقابنا، وأحببنا العذاب الأبدي في الرحلة نحو الأعالي، والتي تنتهي إلى الهاوية مرارًا وتكرارًا.
ولكن ألا يعد ذلك هو الحل الوحيد إذا كان القدر حتميًا؟
قال “كامو” بالفعل في مختتم كتابه إن الحل الوحيد هو “أن نتخيل سيزيف سعيدًا”، أي نحب مصيرنا ونتصالح معه، ونتخيل أن التجربة البشرية، بآلامها ولذاتها، بها ما يكفي لكي يشعرنا بالسعادة.
ولكن ربما يكمن السر في حقيقة وحيدة غائبة، هي أن نحمل صخرتنا بشجاعة، دون أن نحبها، دون أن نُحمّل أنفسنا مسؤولية الضعف أمام الثقل الهائل على كواهلنا، دون أن ننسى أن تلك الصخرة حتى وإن كان وجودها حتميًا، فإن مقاومتها ممكنة، مقاومة كتلتها الضخمة، وتفتيتها، لعل تكون الرحلة أيسر نحو الأعالي.