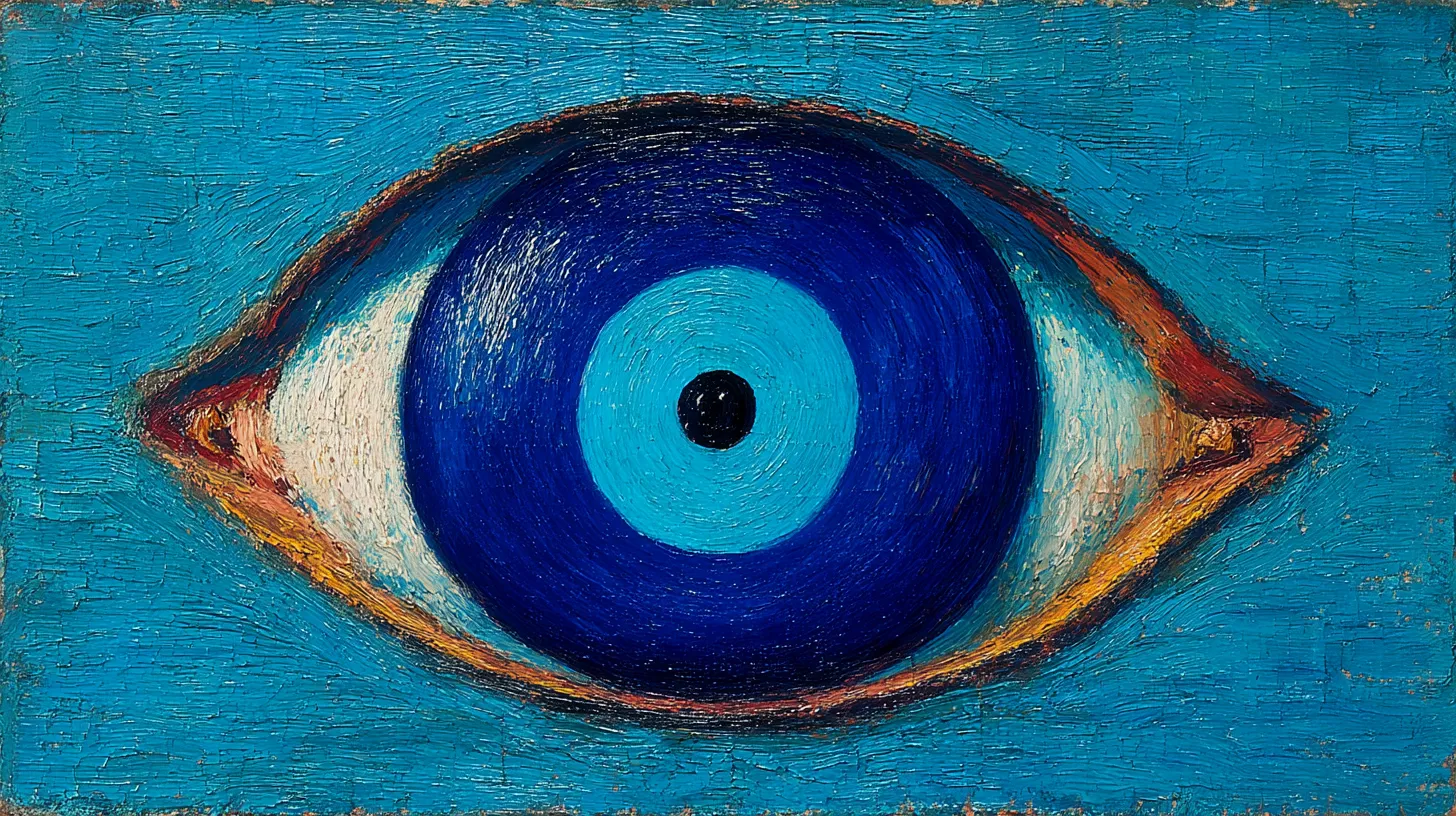من المخطئ في رأيك في المثل الشعبي “اللي ما يعرفك يجهلك”؟.. بالضبط.. لا أحد.
فرغم النبرة شبه الاعتذارية التي يقال بها المثل عادة، والتي تبرر جهل فرد ما بمقام متلقي المثل، إلا إن الاعتذار مغلف بقاعدة عامة، تبدو، للوهلة الأولى، بديهية ساذجة أكثر منها نتاجًا للخبرة، وبالتالي فهي تنفي الخطأ من الأساس.
إذ المعنى الحرفي للمثل: لا يعرفك من لا يعرفك.
ولو كانت الخبرة البشرية المباشرة تعتقد بعدم إمكانية التعرف على مكانة فرد ما دون أن يفصح هذا الفرد عن هذه المكانة بشكل لفظي معزز بالدلائل القاطعة، لما كانت هناك حاجة إلى المثل، فالمثل تحديدًا يتدخل في الحوار، ليقول إن معرفة المكانة ليست بالأمر السهل والمباشر، وإذن هو يقال في وضع يكون فيه الفهم السائد، أن المكانة يمكن التعرف عليها بسهولة دون الحاجة للتدليل عليها. بتعبير آخر، يقول المثل شيئًا بديهيًا في وضع ذي بداهة مناقضة (فالبداهة، في النهاية، منتج ثقافي).
في كتابه “تقديم الذات في الحياة اليومية”، يحاول عالم الاجتماع إرفنج جوفمان، كما هو واضح من العنوان، تشريح كيف نقدم ذواتنا إلى الآخرين في حياتنا اليومية، هذا التقديم، لا يعتمد فقط على إخبارهم بأسمائنا ومكانتنا المفترضة، بل على أن نؤدي “دورًا” مسرحيًا، لنمرر إليهم معلومات تخبرهم بالهوية التي عليهم التعامل معنا على أساسها. هذه الهوية، ليست تمامًا ما نحن عليه بالضرورة، وليست تمامًا هوية مزيفة، إنها دور نلعبه ونحاول إقناع الآخرين أن يلعبوا معنا على أساسه. ولو عدنا للمثل مرة أخرى، لأصبح لدينا احتمالان للخطأ، خطأ من متلقي المثل أنه لم يستطع لعب دوره جيدًا، وأرسل إشارات متعارضة أدت إلى أن يجهله الشخص الآخر، واحتمال أن متلقي المثل لعب دوره جيدًا، لكن الآخر هو من أخطأ تفسير إشارات الأول.
لنأخذ مثالًا صارخًا نقوم فيه بتقديم ذواتنا للآخرين، في مشاجرة في الشارع، يحاول كلا الطرفين، أن يقدم ذاته إلى الآخر، بحيث تُظهر تلك الذات قدرة على إلحاق ضرر هائل بالآخر، هذا الضرر قد ينتج عن مكانة الذات المجتمعية، علاقاتها بالسلطة أو بالعزوة أو بالمكان الذي تحدث فيه المشاجرة. يعبر الفرد عن “الذات” التي يريد من الآخر أن يلعب على أساس التسليم بصحتها. لكن الآخر يفعل الشيء نفسه تقريبًا، وإذا لم يملك أحدهما دليلًا ناصعًا على ادعائه، يميل الطرفان للتمسك بقواعده الخاصة للعبة، وإذا طالت المشاجرة بما يكفي ليكون في وسع الصادق فيهم تقديم دليل أصالة دوره، دون أن يقدم ذلك، يصبح الشك في ادعائه أكثر منطقية، ولذلك هناك طريقة أخرى، لإيصال قدرة الذات على إلحاق الضرر، أي الجنون، أو الذات “التي قطعت بطاقتها”، ذات بلا تعريف وبلا محددات وبلا خطوط حمراء، هذه “الذات” الجديدة قادرة، بحكم جنونها، على إهمال كل قواعد اللعبة، وبالتالي القاعدة الوحيدة للعب معها هو مغادرة اللعبة، ورغم أن استراتيجية اللعب الأولى، أي الذات صاحبة المكانة، تبدو قابلة للتكذيب بسهولة، حينما تعجز عن إثبات دلائل مكانتها، إلا أن الأمر نفسه ينطبق على الاستراتيجية الثانية حينما يكون الخصم، محترفًا كفاية لكي لا يشتري جنون الذات الأخرى، وإذن يتجنن هو بدوره، وفي هذه الحالة، قد يضطر الطرفان بالفعل إلى أن يكونوا مجانين، إذا لم يخطئ أحدهم في التمسك بدوره، وبإيماءة غير مقصودة، يعطي للآخر “معلومة” أنه ليس بالجنون الذي يدعيه، وأنه في الحقيقة يريد قواعد للعبة.
بالطبع لا نقدم ذواتنا بهذه الفجاجة في أغلب الأحيان، بل تكفينا إيماءات وإشارات بسيطة، لنكوّن عند الآخرين “الانطباع” الذي نريده، هذه الإيماءات البسيطة في الغالب لا تحدث على مستوى الوعي، إذا ما تبنينا فكرة بيير بورديو عن “الهابيتوس”، والتي هي الاستعدادات المكتسبة بالتجربة والبيئة، التي تولد أفعالنا وردود أفعالنا، هذه الاستعدادات هي ما تمكننا من أن نؤدي دورنا دون الوعي بأننا نؤديه.
مثلًا، إذا ذهبت إلى مطعم فاخر مكلف، وأنا رجل من عامة الشعب ليس هذا المكان من أماكني المعتادة، قد أرتبك، نتيجة لتصوري أن علي أن أظهر كأن هذا المكان من أماكني المعتادة، وإذن أحاول “تمثيل” هذا الدور، مستندًا إلى معلوماتي عن طريقة التعامل المثلى، لكن هذا التمثيل أمام الجمهور، قد يتعطل لوهلة، حين أنظر إلى الفاتورة باندهاش، حتى لو لم أتلفظ صراحة باندهاشي هذا، وإذن أمرر، بالرغم مني، إلى الآخرين، معلومة أنني في الحقيقة لا أنتمي إلى هذا المكان. وقد تكون الفاتورة مدهشة فعلًا، ولكن فقط الذات المرتاحة مع المكان، والمتماهية تمامًا مع دورها، وحدها القادرة على أن تطلب من النادل مراجعة الفاتورة.
المجاز المسرحي الذي يختاره غوفمان لتحليل التفاعلات اليومية، يذكرنا بأننا لا نعرض للآخرين “شخصياتنا” كما هي دائمًا، بل نعرض دورنا في المسرحية، هذا الدور قد يكون دورنا فعلًا، فغوفمان يتحدث عن أن الطبيب في المستشفى يظل يؤدي شخصية الطبيب، والنادل في المطعم يقدم شخصية النادل، والمدير في الشركة يؤدي شخصية المدير، وهي أدوار لها مرجعية معيارية لدى كل من الجمهور والمؤدي، وكثيرًا ما تكون المسرحية جماعية، فنؤدي جميعًا أدوار طاقم المستشفى، أو أدوار طاقم الشركة، المدير يلعب المدير والموظف يلعب الموظف، ويتعاون الفريق لإخراج المسرحية كأنها حقيقية، حتى لو كانت حقيقية فعلًا. في المقابل، يذكرنا بورديو، بأننا لا نؤدي بالضرورة، بل نتشرب أدوارنا في المجتمع، وبقدر تشربنا لدور معين، يمكن لهذا الدور أن يخرج منا كأنه طبيعي، وهو ما يجعل لبعضنا ميزة على بعضنا الآخر في لعب أدوار اجتماعية، تبدو للوهلة الأولى عادلة ومُتاحة للجميع.
تظهر الفروق الدقيقة بين الأداء و**”الطبيعة المكتسبة”**، حين ننتقل من دور إلى آخر، أظهرها هو الثراء السريع، إذ الثري المحدث يحاول أن يؤدي دور الثري، لكن تنقصه الدربة الكافية لهذا الدور، فغالبية معلوماته عن الثراء هي ابنة وضعه القديم كفرد من طبقة أخرى، هكذا يحاول عبدالغفور البرعي تأثيث بيت سنية حسب معرفة غير دقيقة بمعايير الأثرياء عن “الأثاث الفخم”، مستندًا إلى معرفته الآتية من تصورات طبقة غير ثرية عن الثراء، وإذا ما انجرفت خلف انطباع غير مدروس، سيبدو لي نموذج عبدالغفور البرعي أقلويًا داخل الدراما المصرية، فقد حفلت الدراما المصرية من السبعينات فصاعدًا بالضجر من الصعود غير العادل لشرائح اجتماعية إلى مصاف النخب، نتيجة للانفتاح الاقتصادي، دون امتلاك الجدارة والمؤهلات اللازمة لهذه المكانة، من منظور مخرجي هذه الأعمال، ولهذا توجب على شخصية عبدالغفور، عدم الاكتفاء بالصعود الطبقي الناتج عن كفاح عصامي، بل التدليل مرة تلو أخرى، على جدارتها بمكانتها الجديدة، الجدارة التي شكك فيها محفوظ سردينة طويلًا، ولهذا تكثر الإشارات إلى ذكاء عبدالغفور ودهائه بجانب دأبه وشقائه، كما أن أميته، يجري تعويضها بمتابعته الدؤوبة للصحافة التي يقرأها له يوميًا فهيم أفندي.
ربما ما يفرق مقاربة الطبيعة المكتسبة عن الأداء، هي الانسيابية التي تبدو معها “الشخصية” كأنها محفورة في المؤدي، أننا لا نلمح أبدًا المؤدي وهو يفكر في الكلمة الصحيحة أو رد الفعل المثالي، بل يقول أو يفعل ما هو مثالي لشخصيته دون عناء، مثلما يراوغ ميسي المدافعين
، وتفترض فكرة الأداء، بحسب فهمي، وجود معيارية أولية، أو بحسب بورديو، تشفير للواقع، أكواد محفوظة تنطبق على الجميع، وتجعل من السهل الالتزام بالدور، لتخلق لنا “الشكل الرسمي” للتعاملات، في غياب هذه الأكواد، أو ندرتها، تكون الأشياء متروكة، بحسب بورديو، لـ”حس اللعبة” والارتجال. وإذا كان فهمي صحيحًا، فبورديو، يرى أن الطبيعة المكتسبة، هي الملاذ حين غياب تلك الأكواد، وإذا أكملنا في مثال المطعم، فلو كانت هناك أكواد محفوظة وكاملة لكيفية التصرف في مطعم فاخر، فأي شخص يمكنه أن يلعب هذه اللعبة، ولكن لأن الأكواد لا تغطي كل شيء، يصير لبعض الأفراد ميزة واضحة في اللعبة، إن وجودهم في أماكن شبيهة طوال الوقت، أكسبهم “حسًا باللعبة” أفضل من عامة الشعب أمثالي.
ففي غياب الأكواد يرتجل المرء دوره مع آخرين يرتجلون أدوارهم، وهذا الارتجال المتبادل يعني عدم تحكم أي منا في إخراج المسرحية التي نؤديها معًا، أو بتعبير غوفمان، نجد أنفسنا، إذا أخطأ أحدنا دوره، دون مسار مخطط للفعل، لكن، بحسب فهمي لبورديو، بعضًا منا سيظل ارتجاله أفضل من غيره. هذا الارتجال، هو الحالة التي قد يجد المتشاجران أنفسهم فيها، حين ينكشف كل منهم، بعد فقرة الجنون المتبادل، عن شخص عقلاني بارد مقدر للمخاطر، يريد قواعد للعبة، بعدما أمضى وقتًا طويلًا في ادعاء العكس، إذ سقوط الأقنعة بشكل متزامن، ومضحك، يجعلهم في حالة عراء، لا يعرفون معه كيف يمكن الاستمرار في اللعبة. الوصول لهذه اللحظة، يعني أن كلًا منهم لم يمتلك من البداية، حسًا باللعبة أفضل من خصمه.
…
ويُحتمل بالطبع، أن نؤدي أدوارًا مختلفة، حسب السياق، لذلك يشير جوفمان إلى أننا نظهر جانبًا مختلفًا من ذواتنا البشرية المركبة والمعقدة حسب الجمهور، فلا نظهر أمام أسرتنا، كما نظهر أمام أصدقائنا، ولا نظهر أمام الاثنين كما نظهر في العمل. هذه الأدوار المختلفة، تتعارض مع افتراض الجمهور، أو طلبه، تماسكًا في الشخصية، وهو ما يجر معه، محاولات عزل كل جمهور عن الآخر، بحيث تصير شخصيتنا متماسكة دائمًا أمام كل فئة من الجماهير على حدة.
لكن يحدث أن يتمكن جمهور شخصية معينة من رؤية شخصية أخرى، هكذا تمكن ياسين عبدالجواد، في رواية “بين القصرين”، من رؤية والده المهيب الحازم الذي لا تُرد له كلمة، السيد أحمد عبدالجواد، وهو يضرب بالدف في “قعدة أنس” مع الراقصة زبيدة، يكتشف ياسين أن “شخصية” والده، مجرد دور، أو على الأقل تقدير، أنها جانب فقط من شخصيته، وها هو يقع على جانب آخر، دور آخر، مختلف تمامًا، في مسرح مختلف تمامًا، مع ذلك يبدو السيد أحمد عبدالجواد متمكنًا منه تمامًا، بالنسبة لي، إنها أحد لحظات الثلاثية المركزية، انفتاح المسارح على بعضها، بالنسبة لياسين لم يعد والده “بعيدًا عزيز المنال مغلق الأبواب” ولكن دانيًا قريبًا، قطعة من نفسه وقلبه، أبًا وابنًا، روحًا واحدة، ليس الرجل الذي يرعش الدف في الداخل السيد أحمد عبد الجواد، ولكنه ياسين نفسه، كما يكون وكما يجب أن يكون، وكما ينبغي أن يكون، لا يفرق بينهما إلا اعتبارات ثانوية من العمر والتجربة:
«هنيئًا لك يا والدي، اليوم اكتشفتك، اليوم عيد ميلادك في نفسي، يا له من يومٍ ويا لك من أب!
لم أكن قبل الليلة إلا يتيمًا، اشرب واطرب والعب بالدف لعبًا، ولا يد عيوشة الدفافة،
إني فخورٌ بك، هل تغنِّي أيضًا يا ترى؟»
ما يكتشفه ياسين، ويكتشفه كل جيل عن رموزه في لحظة ما، أنهم ليسوا شخصيات مصمتة أحادية البعد، ذات تماسك درامي، بل أشخاصًا عاديين، يرتقون شخصياتهم على عجل، ويؤدون أدوارهم بحسب ما تسعفهم به معارفهم وطبائعهم المكتسبة وتصوراتهم عن السيناريو المطلوب. صحيح أن هذا الاكتشاف يبدو صاعقًا في البداية، لكنه كثيرًا ما يؤدي إلى التعاطف والتماهي، إذ ما يكتشفه الجيل الجديد عادةً، لا يزيد عن حقيقة أن الجيل الأقدم، هو نفسه جيل يختبر الحياة للمرة الأولى، ومثله مثل الجيل الجديد، يفتقر للأكواد التي تغطي كل فعل، أو للسيناريو المحكم والمفصل الذي لا يدع فرصة للارتجال. وحتى تلك المهارات والميزات الطبقية والرمزية التي نرثها من وجودنا في بيئة بعينها، والتي قد تعطينا ميزة تنافسية، غير منظورة، على الآخرين، لا تعفينا تمامًا من الارتجال، والتجربة والخطأ، إنها، في أحسن الأحوال، تمنحنا ميزة الاستمرار في اللعب مهما ارتكبنا من مخالفات.
…
في كتاب جوفمان، لا يسع المرء إلا التفكير كثيرًا في هشاشة الواقع الذي قد يتهشم عند أي خطأ أدائي، هشاشة تذكرني بجملة شيمبورسكا:
“وُلدنا دون مهارة، وسنموت دون خبرة”.
لا من حيث مناسبتها لحالة سقوط الأقنعة في لحظة ما من اللعبة، بل بوصفها تذكيرًا بأننا جميعًا نلعب اللعبة للمرة الأولى، هكذا دون أي مهارة، ودون وقت كافٍ أبدًا لاكتساب الخبرة، لأن، في الأصل، لا شيء يحدث مرتين.