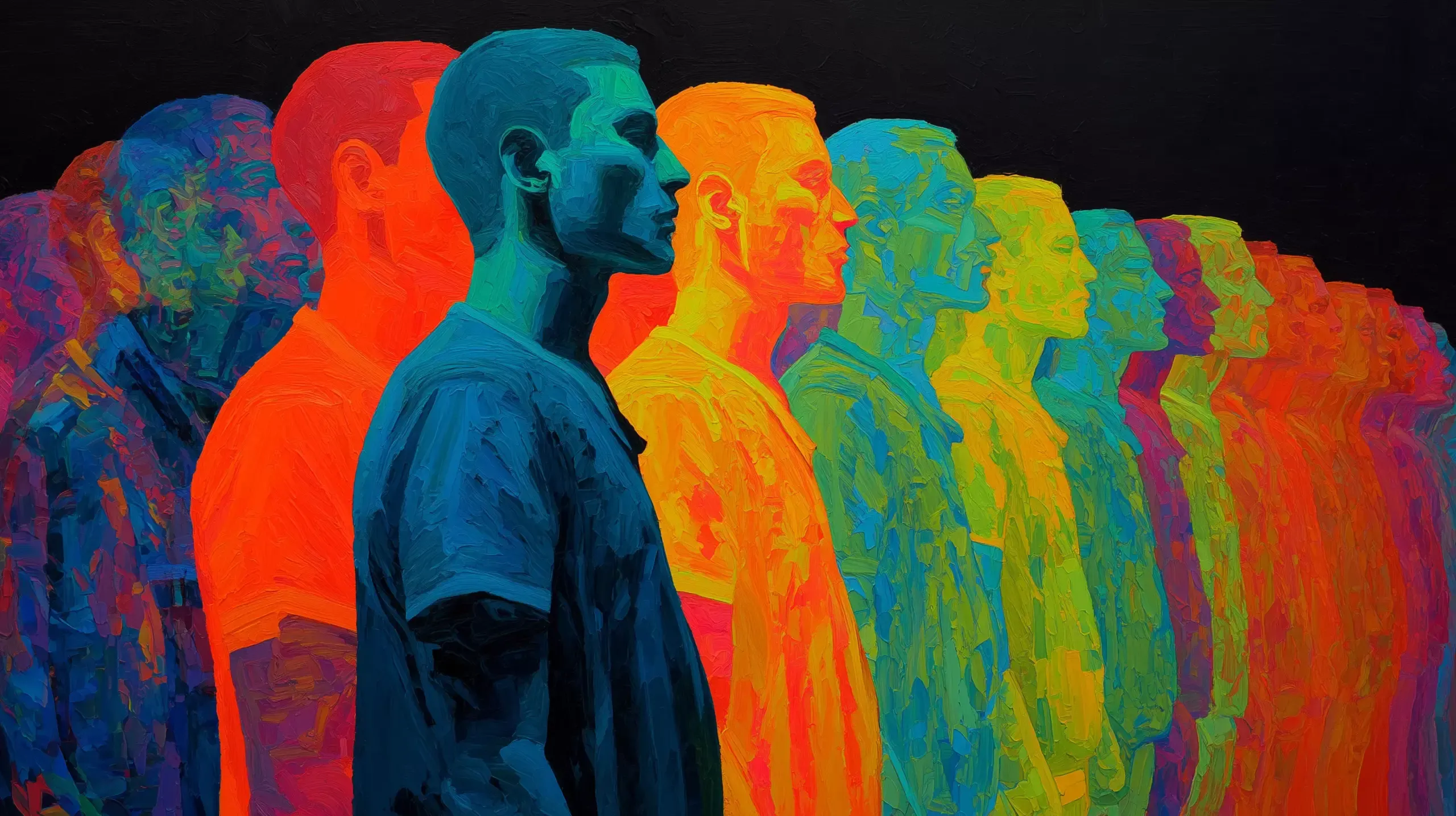يروي الأديب والفيلسوف الفرنسي ألبير كامو في رواية الغريب قصة رجل يشعر بالملل، ليس الملل التقليدي الذي يعاني منه الجميع بين لحظات السعادة والنشوة المتقطعة، بل الملل الوجودي، السأم من جميع الأفعال وحتى المشاعر، الذي يستحيل فيه الإنسان آلة ميكانيكية تتحرك بقوة الدفع كما لو كان لا يمتلك إرادة حرة. يرى كامو في روايته الأيقونية، التي تعد من أكثر الأعمال الأدبية مبيعًا في التاريخ، أن حياة الإنسان يغلفها العبث، أي غياب القيمة النهائية والمعنى الجوهري من الوجود، وبمجرد إدراك هذه الحقيقة ينزلق الإنسان نحو السأم والسخط والشعور باللاجدوى، ما يقود في النهاية إلى تحول الحياة لعبء ثقيل يناضل الإنسان من أجل تحمله.
للمفارقة، وجدت ورقة بحثية نشرت بمجلة Communications Psychology أن مشاعر الملل قد ازدادت خلال الـ15 عامًا الأخيرة، اعتمادًا على بيانات لمئات الآلاف من الأشخاص في أميركا والصين؛ تأتي تلك الحقيقة في ظل نمو وسائل الترفيه بشكل كبير وسهولة توفرها. هنا يجدر بنا التساؤل حول العديد من الإشكاليات الخاصة بمشاعر الملل، بداية من تفشي الشعور بالملل مؤخرًا رغم التطور المذهل في صناعة الترفيه، وصولًا إلى طبيعة الملل الملتبسة التي حيّرت الفلاسفة على مدى قرون.
إدمان التسلية
تجادل الصحفية الأميركية مانوش زوموردي في كتابها Bored and brilliant أن هناك علاقة سببية مباشرة بين التوسع في صناعة الترفيه والتسلية عبر المنصات الرقمية المختلفة وزيادة معدلات الشعور بالملل. حيث تقول مانوش في كتابها إنه في الماضي كان الناس يتعاملون مع الملل بطرق تأملية وإبداعية غنية، مثل القراءة أو ممارسة رياضة ما أو حتى التفكير العميق، أما اليوم أصبح البشر يبحثون عن إشباع فوري لأي لحظة فراغ عبر متابعة المنصات الرقمية المختلفة. ذلك الاعتماد على الإشباع الفوري للحظات الملل العابرة صنع عادة أقرب إلى أن تكون إدمانًا، حيث لم يعد يستطيع الفرد أن يتحمل مشاعر الملل الطبيعية، فكلما كان الإشباع سريعًا، كانت مداهمات مشاعر الملل سريعة أيضًا، إذ تألف العقول التحفيز السريع والمتواصل، ولا تعدْ تشعر بالرضا عن الأنشطة البطيئة أو العادية. كما صنعت مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا بيئة تنافسية سامة يضطر فيها المستخدم – دون إرادة واعية منه – أن يقارن حياته بحيوات الآخرين، فينتهي به الأمر إلى السأم والإحباط بسبب الاختلافات الكبيرة بين أنماط المعيشة. فتكون المحصلة الأخيرة أن محاولة هزيمة الملل بالتسلية الدائمة جعلت مشاعر الملل أكثر شراسة وعدوانية، لذا فإنه من الوجاهة المنطقية التساؤل حول كيفية التعامل مع مشاعر الملل بالطريقة الصحيحة، وهل هناك طريقة صحيحة، وربما السؤال الأهم، لماذا نشعر بالملل من الأساس؟
بين الهروب والمواجهة
ربما يعود أبرز تناول للملل في تاريخ الفلسفة إلى الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور صاحب المقولة الشهيرة
“الحياة تتأرجح كالبندول بين الألم والملل”.
حيث رأى شوبنهاور أن حياة البشر لا تنطوي إلا على وجهين لا ثالث لهما، إما الألم أو الملل، ويكون الانتقال بينهما على أساس موقع الإنسان من الإرادة. إذ عندما تتعرض إرادة الإنسان لمقاومة من العالم يكون الألم، أما إذا نجح الإنسان في إخضاع العالم لإرادته، وأضحت الحياة سهلة ميسرة، يكون الملل. وبناءً على ذلك يدعو شوبنهاور إلى الزهد العام والتخلي عن جميع الرغبات من أجل عيش حياة خالية من الملل وكذلك الألم. إلا أن تلميذه نيتشه اختلف مع أستاذه جذريًا، حيث رأى أن الشعور بالملل نتيجة لخضوع الإنسان إلى قيم تعزله عن إنسانيته، والحل هو عكس ما اقترحه شوبنهاور تمامًا، حيث دعا نيتشه الإنسان إلى إنفاذ إرادته بقوة في العالم، ومن هنا يتخلص الإنسان من الشعور بالملل. تلك الفكرة التي طورها لاحقًا الفيلسوف الفرنسي المعاصر ميشيل أونفري الذي يعد فيلسوفًا لذّاتيًا، يؤمن بالمتعة ويبشّر بها، فقد جادل أونفري بأن حل مشكلة الملل الذي يغلف الحياة هو الانخراط المفرط في حياة مؤسسة على البحث الدؤوب عن المتعة الحسية أو حتى الفكرية. برغم التباين بين الحلول التي اقترحها الفلاسفة، من اعتزال العالم إلى مواجهته بعنف، لكنهم اتفقوا جميعًا على أن الملل مشكلة يجب محاربتها والتغلب عليها بطريقة أو بأخرى؛ إلا أن هناك منظورًا آخرًا، منظور لم يعالج الملل بوصفه مشكلة يجب حلها.
الملل أصل الشرور
يرى الفيلسوف الدنماركي سورين كيركغارد الملل على نحو مغاير تمامًا، إذ لا يعتبره أزمة يمكن للإنسان التغلب عليها عبر بعض التكتيكات الفكرية، بل يرى كيركجارد الملل باعتباره مشكلة وجودية عميقة ترتبط بوجود الإنسان من الأساس، وأن السبب الحقيقي وراء الشعور بالملل هو افتقار الإنسان للمعنى، لذلك يهرب الإنسان من هذا الشعور بالتسلية السطحية أو الامتثال الأعمى للمجتمع. لم يكتفِ كيركغارد بذلك، بل اعتبر أن “الملل هو أصل كل الشرور”، إذ عندما تسيطر مشاعر الملل على الإنسان يذهب للبحث عن أي منقذ يملأ به فراغه ويعينه على هزيمة الملل، حتى لو كان ذلك عبر تدمير نفسه أو تدمير الآخرين. يتوسع كيركجارد في تشريح مشاعر الملل، إذ لا يعتبر الملل مجرد إحساس عابر، بل علامة على الخواء الداخلي، وأن أحد الأفخاخ الأساسية التي يقع فيها الإنسان وتقوده إلى هاوية الملل هو العيش وفق المستوى الجمالي للحياة، أي البحث عن المتع الحسية واللذات الجسدية، واعتبار إشباع تلك الحاجات هي المعنى النهائي للحياة، ذلك ما يدفع إلى الملل في النهاية، لأن المتع الحسية بحسب كيركجارد مؤقتة وزائلة.
يناقش كيركجارد في كتابه إما – أو هذه المشكلة باستفاضة، ويقترح حلًا لها، ولكن على عكس الفلاسفة الذين تحدثنا عنهم سابقًا، لا يدعو الفيلسوف الدنماركي إلى الهروب من مشاعر الملل أو إشباعها عبر اللهو والتسلية، بل يجادل بأن الحل يكمن في استيعاب الإنسان لهذا الشعور باعتباره أحد الأعراض الأصيلة للوجود. كما يدعو إلى استغلال ذلك الشعور غير المحبب من أجل تخطي العيش على المستوى الجمالي، والذي اعتبره سطحيًا، والوصول إلى العيش على المستوى الأخلاقي والقيمي، حيث يستطيع الإنسان في هذه الحالة أن يجد معنى أعمق من المستوى الجمالي، ذلك المعنى الذي قد يكون طوق النجاة للإنسان من أجل أن يحيا جنبًا إلى جنب مع الملل كزميلين يرتبط وجود كل منهما بالآخر، وليس كعدوين يسعيان إلى إنهاء وجود بعضهما البعض.
في تلك اللحظة يغدو شعور الملل القاتل الذي أرهق البشر عبر الزمن، وحيّر الفلاسفة، ليس عقبة يجب على الإنسان أن يتجاوزها ليعيش حياة سعيدة، بل عنصر أساسي من عناصر الوجود البشري، حتى وربما أكثر من ذلك، فبحسب كيركجارد ربما يكون الملل عنصر ضروري يدفع الإنسان في طريق التخلي عن السعادة الإدمانية اللحظية، والبحث عن السعادة الحقيقية.