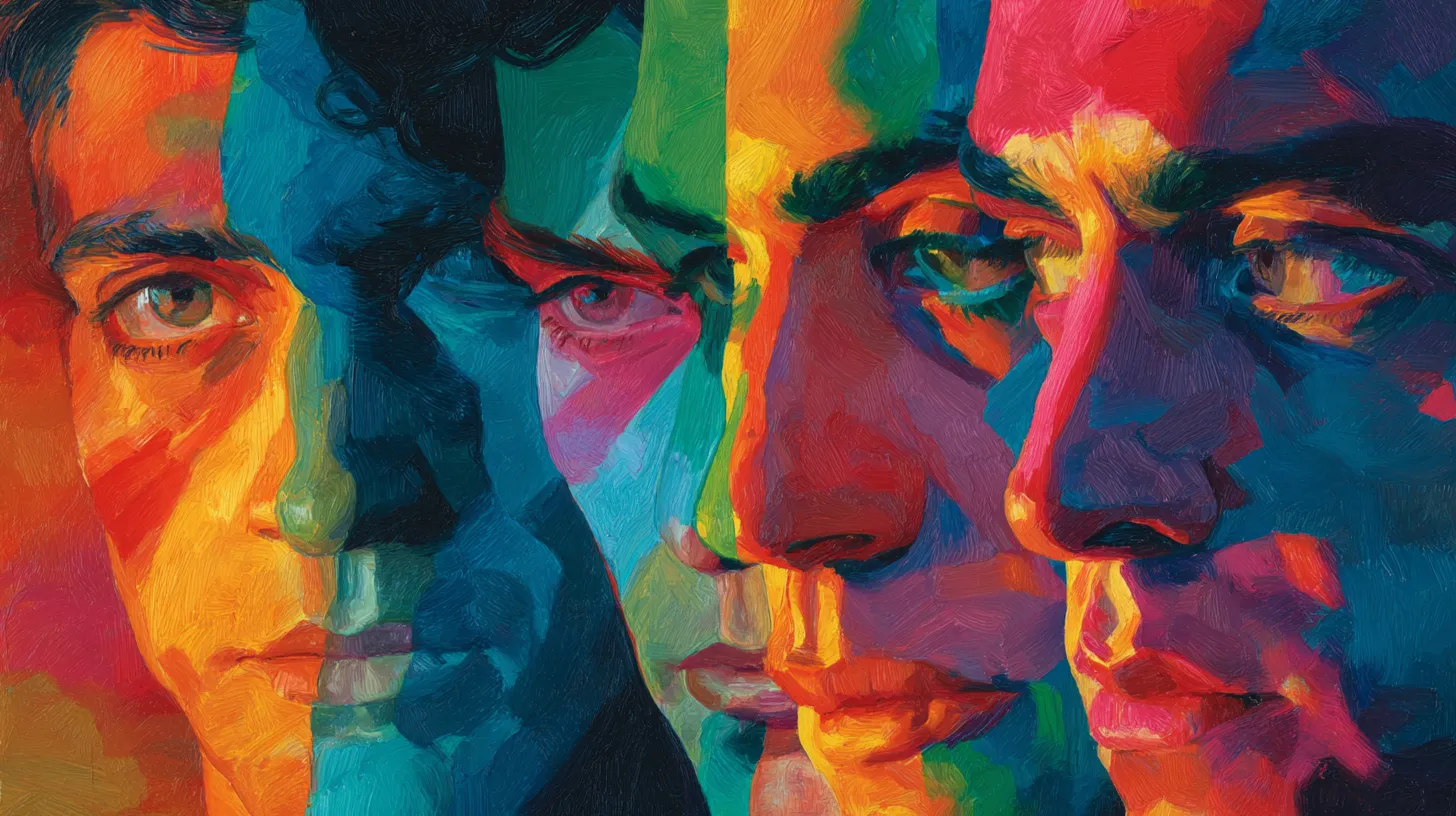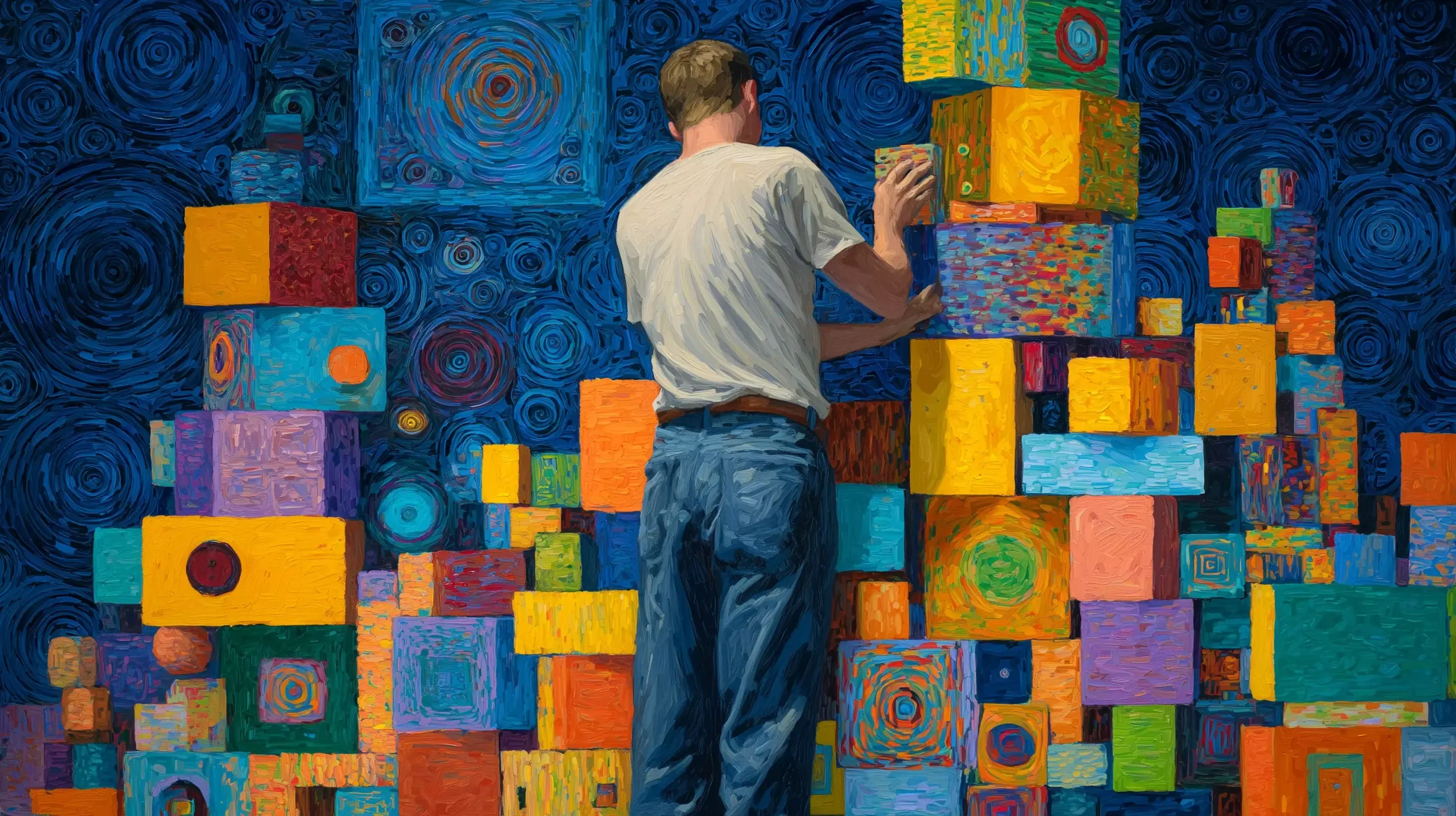عن لحظة نادرة من الهدوء بين جيلين صاخبين
هناك لحظة لا يهيّئك أحد لها، ولا تأتي بإعلان مسبق. تكون جالسًا، ربما في سيارة أو مقهى أو على طاولة بسيطة، وفجأة… تبدأ في التحدث مع أبيك. لا كطفل يحاول أن يُثبت شيئًا، ولا كرجل يحاكم ماضيه، بل كإنسان وجد أن العمر قد مضى، وأن المسافة التي ظنها شاسعة، ليست سوى بضعة كلمات لم تُقل في الوقت المناسب. في طفولتنا، الأب كان شيئًا أبعد من أن يُسأل، أو يُفهم. كان موجودًا، ثم لم يكن. كان الصباح الذي يغادر فيه مبكرًا، أو المساء الذي يعود فيه متعبًا، أو الصوت الحاد في الخلفية.
وكانت بيننا وبينه لغة من نوع غريب: صامتة، مشروطة، مختصرة، ومحمّلة بكثير مما لم يُقال. كبرنا. واكتشفنا أننا لم نعرفه. ولا هو عرفنا كما كنا نظن. وأن بيننا وبينه أرشيف كامل من الافتراضات، والمواقف، والتفسيرات الناقصة، وسوء الفهم الذي لم يُعالج. أردنا أن نختلف عنه، أن لا نكون مثله، وربما حاول هو أن يُصلح أخطاء أبيه فينا، فزاد الأخطاء. لكن الزمن، بطريقته الهادئة، يعيد ترتيب المسافات. يُنكّس الصور القديمة، ويجعلك ترى الوجوه — لا كرموز، بل كبشر. حين يكبر الأب، ويضعف صوته، وتخفت سلطته، ولا تعود عيناه صارمتين كما كانت، تكتشف أنك لا تواجه “السلطة” كما كنت تظن، بل إنسانًا آخر مثلك… مليئًا بالندم، بالقصص المقطوعة، وبالحاجة إلى أن يسمعه أحد.
في علم النفس الأسري، هناك مفهوم يُدعى التحوّل في الأدوار. هو حين يبدأ الابن في رعاية الأب، لا جسديًا فقط، بل عاطفيًا أيضًا. وحين تحدث تلك النقلة، يتحوّل التوتر القديم إلى شيء آخر: لا نغفر تمامًا، ولا ننسى، لكن نُعيد توزيع الأهمية. لم تعد غاضبًا كما كنت، لأنك لم تعد طفلًا. ولم يعد هو مهيمنًا كما كان، لأن الحياة هزّته بما يكفي.
ذات مرة، جلست مع والدي وسألته سؤالًا بسيطًا: “ما أكثر شيء ندمت عليه؟” صمت، ثم قال جملة لم أكن أتوقعها: “أنني لم أكن أعرف كيف أتكلم معكم.” في تلك اللحظة، فهمت شيئًا. الآباء لا يعرفون أحيانًا كيف يكونون آباء، تمامًا كما لا نعرف نحن كيف نكون أبناء. نمارس الأدوار كما وصلتنا، لا كما اخترناها. ولذلك، فإن الحديث مع الأب حين نكبر لا يعني أن نعيد كتابة الماضي، بل أن نمنح الحاضر لغة جديدة.
فيلسوف مثل مارتن بوبر يفرّق بين علاقتين: “أنا – هو”، حيث نرى الآخر كوظيفة، كدور، كأداة. و**“أنا – أنت”**، حيث نرى الإنسان ككائن حيّ، حاضر، حقيقي. وما نحتاجه مع آبائنا، بعد النضج، هو هذا: أن نخرج من علاقة “هو”… إلى علاقة “أنت”. ألا نراه كمن قصّر فقط، أو كمن فشل في فهمنا، بل كمن كان يعيش بقدر ما يعرف، بقدر ما سُمِح له، وبقدر ما استطاع.
في علم الأعصاب، يُقال إن التذكر المشترك يعيد تشكيل الروابط العصبية. بمعنى، أن الجلوس مع من نشاركهم الذاكرة، والحديث عن الماضي، يُعيد بناء الروابط المتآكلة. ولذلك، فإن أبسط الحديث — “فاكر لما كنا في المصيف؟”، “بتحب أي أكل؟”، “إيه اللي مفرحك اليومين دول؟” — ليست أسئلة سطحية. بل نُقاط عودة. نعود بها إلى شيء إنساني بسيط، أننا كبرنا، وأن الوقت لم يعد طويلاً كما كنا نظن، وأننا نستحق علاقة لا تحتاج إلى صراع دائم لإثبات الندّية.
لن يكون الحديث مثاليًا. سيظل الأب يقول أشياء تزعجك. وستظل تشعر أحيانًا أنه لا يفهمك. لكن ستكتشف شيئًا أجمل من الفهم: القبول. أن تكون حاضرًا، أن تُنصت، أن تسأل، أن تضحك، أن تختلف دون حرب. أن تقول، دون كلمات كثيرة: “أنا هنا. وأراك.” وفي النهاية، قد لا تكون المصالحة الكبرى ممكنة. لكن المحاولة، وحدها، كفيلة بأن تُخفف الثقل الذي حملته طويلًا… باسم الأب. … وباسم الابن أيضًا. لأننا نحن أيضًا لم نكن واضحين دائمًا. كم مرة أسأنا الظن؟ كم مرة حكمنا عليه من خلال ضعف لحظة، لا مجموع حيواته؟ كم مرة اعتقدنا أن غيابه عن مشهد ما هو لامبالاة، بينما كان في مكان آخر يقاوم شيئًا لا نعرفه؟
العلاقة بين الآباء والأبناء، حين تكبر، لا تُبنى على التسامح فقط، بل على إعادة التفسير. أن نعود إلى المشهد القديم ونسأل: ماذا كان يعني ذلك الفعل؟ وماذا لو لم أكن على حق تمامًا… ولا هو كذلك؟ فحتى الفلاسفة الذين تحدثوا عن “الذات”، وعن “التحرر”، وعن “الهوية المستقلة”، لم يدعُ أحد منهم إلى القطيعة كطريق للنضج. كانوا يدعون إلى الفصل، إلى التمييز، إلى التفكير الحر، لكنهم جميعًا — بشكل أو بآخر — افترضوا أن العودة ممكنة، أن التفاهم بين جيلين ليس خيانة لفرديتك، بل علامة على أنك لم تعد بحاجة إلى الغضب كي تكون.
أنت لا تعود للكلام مع والدك لأنك أصبحت شخصًا مثاليًا، بل لأنك اكتشفت أن وراء الصمت شيئًا مهمًا فُقِد: ربما حكاية مشتركة، ربما محبة لم تُتَح لها اللغة، أو حنين ما، يصعب تسميته، لكنه لا يزول. أنت لا تعود لتطلب شيئًا، بل لتقول ببساطة: أنا لست كما كنت… وأعرف أنك لست كما كنت. فهل نبدأ من هنا؟