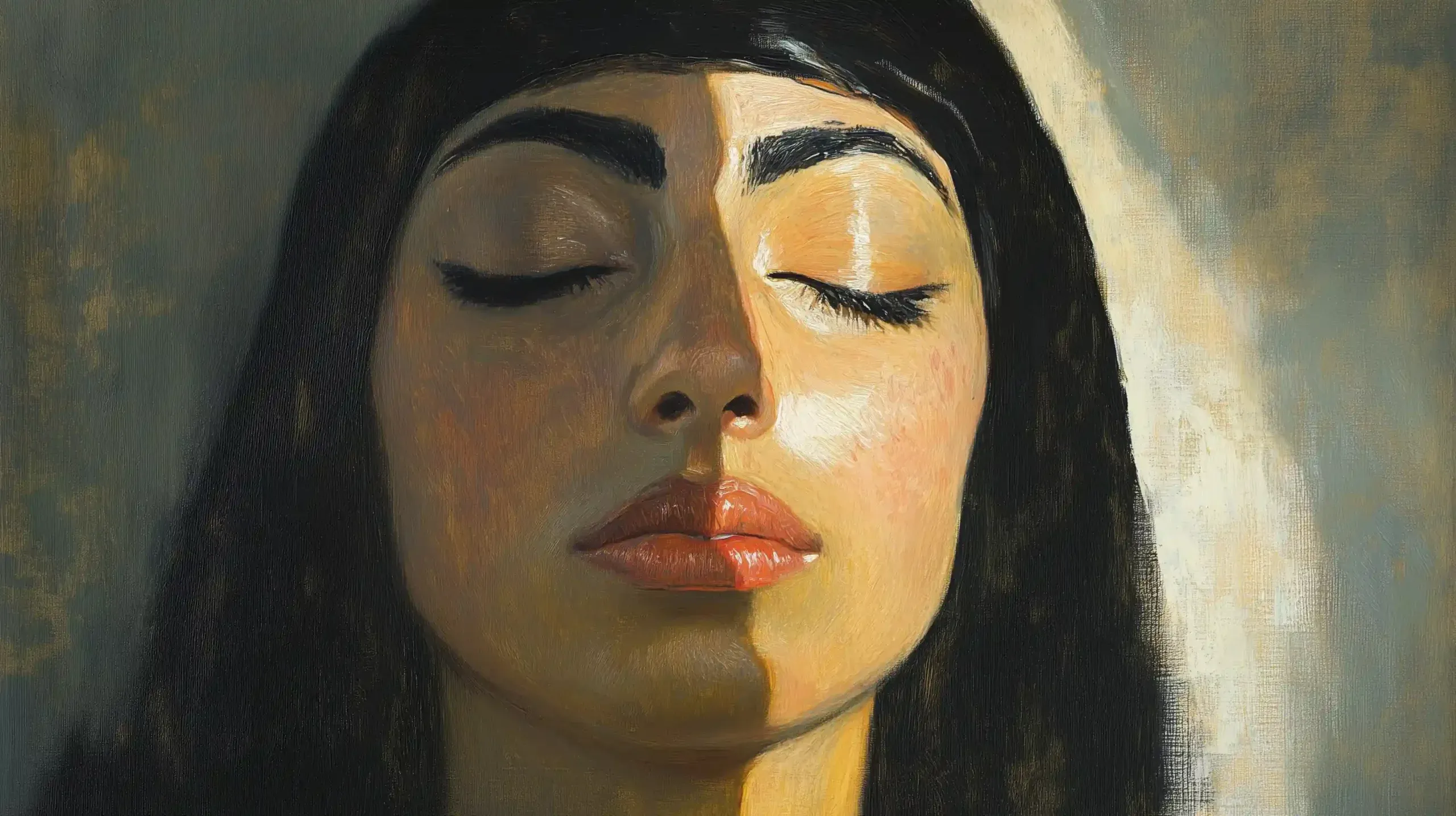لابد أنك مثلي تشعر أن أي حوار مع الأصدقاء سيشق طريقه حتى يصل، في النهاية، إلى الاضطرابات النفسية. بمعنى ما، نعيش في عصر نعتقد فيه جميعًا أننا “معطوبون نفسيًا”.
في كتابه “إنقاذا للسواء”، ينتقد الطبيب النفسي آلين فرانسيس(والذي أشرف على تحرير النسخة الرابعة من “الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، أحد أهم المراجع المعتمدة عند الأطباء النفسيين)، توسع “التشخيص النفسي” بشكل يضيق من مساحة السواء في المجتمع. الطب النفسي يجد نفسه أمام معضلة أن الاضطرابات النفسية ليست قابلة للتعيير العلمي الدقيق، أي لا فرق جوهري يفصل المناطق الحدودية بين المرض والسواء. وعلى الطب النفسي أن يغامر بترسيم هذه الحدود، بشكل نصف اعتباطي يضع في ذهنه، ألا يوسع مساحة السواء، كيلا يحرم بعض من يمكنهم الاستفادة منه، وألا يوسع مساحة المرض، بحيث يضع لنفسه مهمة أكبر منه: أن يعالج أغلب الناس، وبالتالي تقل قدرته على فعل ذلك، كما تقل جودة العلاج نفسه، نتيجة للطلب المتزايد على خدمة محدودة الموارد.(ملحوظة مهمة: في المقال، أتحدث تحديدًا عن الشعور بالشقاء والتماسك النفسي، وعن الخطاب العلاجي كخطاب كلامي وكمنتج ثقافي، ولا يدخل في حيز اهتمام المقال “الجانب الطبي” الخام منه، بل الخطاب العلاجي “الكلامي” داخل العيادة والأهم خارجها، أي كخطاب موجه إلى/يعمل في المجتمع).
لكن انتشار خطاب الطب النفسي، وعلى الأدق تضخم الإنتاج المعرفي المختص بالصحة النفسية، ليس مرده فقط إلى قرار الأطباء النفسيين بتضييق مساحة السواء ولا إلى الدعاية المستمرة من جانب شركات الأدوية كما يشير فرانسيس[1]. فآخرون، مثل الطبيب النفسي ديفيد سميل، في كتابه “أصول الشقاء”، يرى أن السبب هو زيادة الطلب على الخطاب العلاجي لزيادة الشعور بالشقاء، ويرى الشقاء، نتيجة لوضع اجتماعي واقتصادي معين، هو من يخلق اضطرابات نفسية محددة، هذه الاضطرابات لا يمكن معالجتها، كما يعتقد الطب النفسي، بشكل فردي، بل لا يمكن معالجتها إلا عبر تغيير الوضع الذي يخلق هذا الكرب باستمرار(بتعبير سميل، علينا إدراك أن الفرد ليس هو المشكلة للعالم، بل العالم هو المشكلة للفرد).
يرى سميل أن “بصيرة” الطب النفسي محدودة ب”الغرفة” التي يجري فيها العلاج، ولا تصل غالبًا إلى أبعد من الأسرة الصغيرة. وفي الكتاب يتحدث سميل بالتحديد، عن فترة الثمانينات في بريطانيًا، حيث ساهمت السياسات الاقتصادية الرأسمالية، في إجراء تغييرات عميقة في المجتمع، خلخلت النسيج الاجتماعي، وكان الكرب العام أحد نتائج هذه السياسات.(أتصور أن سميل يريد التعامل مع الكرب والقلق، كوباءات نفسية، وليس كمرض فردي، وإذن ينبغي لعلاجه، الذهاب إلى تقنيات مكافحة الوباء، وليس العلاج الفردي).
من منظور سميل، لا يمكن مقاربة الشقاء، دون مقاربة أسبابه، يقع الفرد في مجالات متقاطعة من قوى مختلفة، بعضها قريب منه، وبعضها بعيد جدا حتى يصعب الوعي به، ناهيك عن التأثير فيه. لذلك يرى، أن محدودية بصيرة الخطاب العلاجي، غالبًا ما تنتهي إلى البحث عن المشكلة في المكان المكشوف لها، حتى ولو لم تكن المشكلة بدأت منه.(إنها نكتة جحا التي لا أمل من روايتها، يسأل عابر طريق جحا المنهمك في البحث عن شئ ما، عن ما يبحث عنه؟ فيجيب جحا أنه يبحث عن عملة أسقطها، يسأل العابر إن كان أضاعها في هذا المكان(سؤال متبصر وإن كان يبدو ساذجًا)، فيجيب جحا، أن لا، أضعتها في مكان آخر، ولكن هذا المكان المنير أنسب للبحث).
أدب النصيحة
لطالما أربكني العداء الجارف الحديث لكلمة “معلشي”، لأنه يضع المستمع في موقف مستحيل، من جهة هو يعلم أن المتحدث لا ينتظر حلولًا واضحة لمشكلته، فلأنها واضحة يكون النصح بها يحمل(أو قد يفسر كـ) تهكمًا مستترًا تجاه الشاكي، من الجهة الأخرى يعلم أيضًا أن المتحدث ينتظر اعترافًا بوجاهة شكواه وبصعوبة مشكلته. وكانت مهمة معلشي أن تحل هذا الإشكال، بإعطاء التضامن دون اقتراح الحلول. في المقابل، العداء ل”معلشي”، يعني أن المتحدث ينتظر حلولًا بالفعل، حلولًا قد تكون موجودة، لكن ليس بالضرورة عند المستمع الحالي. وإنما عند ناصح حكيم ما له تجربة قريبة أو مشابهة، إلا أننا غالبًا ما لا نعثر على هذا الحكيم.
وإذن بوسعنا أن نضيف سببًا رابعًا، وهو اختفاء مساحات الإرشاد الاجتماعي “التقليدية”، وأقصد هنا بالإرشاد الاجتماعي، الأشخاص المكلفون بمهمة إرشاد الأفراد إلى كيفية الانخراط في الحياة بعد تعرضهم لظروف صعبة. هذه المهام، كان بيقوم بها، كبار العائلة وأئمة المساجد وآباء الكنيسة، والإخوة وأبناء العم الأكبر، والأصدقاء الحكماء ذوي التجربة. أغلب هذه المساحات انمحت ليس فقط لتراجع الثقة فيها نتيجة لصعود خطاب “علمي” معياري يدعي حيازة معرفة أوثق وأكثر نجاعة. بل نتيجة للأوضاع الاجتماعية ذاتها، التي أجبرت أناسًا كثر على التنقل الدائم من بيئاتهم الأولى، وبالتالي أصبحوا مفصولين عن هذه المساحات. وإذن أضحت هذه المساحات نفسها، أقل قدرة على إرشاد البقية الباقية من مريديها، فإمام المسجد، كما أذكر أنني قرأت للطيبب النفسي همام يحيى، كان يكتسب “الثقة” في إرشاده الاجتماعي، ليست فقط من معرفته “المعيارية” عن الحلال والحرام، بل أيضًا من خبرته ومعرفته بالخرائط الاجتماعية لمحيطه، وهو حين يوجه إرشادًا لأحد، يوجه إرشادًا خصوصيًا على مقاس السائل، لمعرفته بموقع السائل في الخريطة الاجتماعية. وبالإضافة إلى هذه المعرفة بالخرائط، كان لدى الشيخ، الذي يتمتع برأسمال رمزي كبير في محيطه، قدرة على التوسط داخل محيط السائل لمساعدته، وهو إذن كان يعلم أن “تحسن” السائل، لا يكمن في السائل وحده، بل وفي محيطه الاجتماعي. وحين يفقد هذا الشيخ هذه المعارف والقدرات، لا يبقى لديه ما يقدمه سوى “المعرفة المعيارية” للحلال والحرام.
لكن لمساحات الإرشاد الاجتماعي التقليدية عيوبها الظاهرة أيضًا، فهي لانغراسها في النسيج الاجتماعي، غالبًا ما تكون في تحالف مع حقول القوى المسببة للألم النفسي، وكثيرًا ما تضع مصلحة تماسك هذا النسيج فوق مصلحة الفرد، ولهذا كثيرا ما تكون نصائحها منحصرة في أن المزيد من الانضباط بالقواعد والأعراف الاجتماعية سيحل المشكلة. ثم هي محدودة بالأفق المعرفي والاجتماعي للناصح، الذي رغم استعيابه لخبرة مجتمعية عريقة، فهو أقل بصيرة حينما يكون السائل متأثرًا أو متقاطعًا مع “بنى اجتماعية وفكرية” أخرى لم يعرفها الناصح.
الفراغات التي خلفها اندثار “المواطن الطبيعية للنصيحة”، تمدد فيها “الخطاب العلاجي” للطب النفسي. وبالمقارنة بمساحات الإرشاد التقليدية، أعطى الخطاب العلاجي عدة وعود تنافسية،أهمها، الحفاظ التام على سرية ما يحدث داخل الغرفة(وهو الأمر غير المضمون بنفس الدرجة في المساحات التقليدية)، ثانيًا، وضع الصحة النفسية للعميل أولوية على التماسك الاجتماعي. ثالثًا، وربما الأهم، ادعاء امتلاك “معرفة علمية” صالحة لكل الخرائط الاجتماعية، لأنها “علم” عن نفسية الإنسان بما هو إنسان.
على ذلك، من المنطقي أن نتساءل إن كان هو الوريث المثالي لهذه المهمة. فهو وإن امتلك، فرضًا، معرفة معيارية عن السواء والمرض، لا يملك معرفة معيارية عن “كيفية الحياة”، ولا يملك الخرائط الاجتماعية لعملائه، وهو، في أغلب الأحيان، غير قادر على اختراق جدران “العيادة”، والتأثير في المحيط الاجتماعي للعميل. وفي رأي سميل لا يملك الطب النفسي إزاء الشقاء سوى تقديم “الراحة” التي يستقيها المريض من وجود من يفهمه ويتضامن معه، و”التبصر” الذي يساهم فيه الطبيب مع المريض للكشف عن جذور شقائع، و”التشجيع”، الذي يقوم به الطبيب لحث المريض على تغيير حياته للأفضل. ليست هذه المهام الثلاثة بالهينة، لكنها لا تعتمد فقط على “المعرفة العلمية”.
الصداقة المستحيلة
في كتابها “ربما عليك أن تكلم أحد،” تتحدث الكاتبة، الطبيبة النفسية لوري غوتليب، عن بحثها عن طبيب نفسي، لكنها لا تبحث عن طبيب نفسي “مستوفي للمعايير العلمية”، لكن عن طبيب نفسي أربعيني متزوج ولديه أولاد، ليكون لديه خرائط معرفية واجتماعية قريبة من الخرائط التي يحملها خليلها التي انفصلت عنه لتوها. وبالتالي قدرة أكبر على الحكم ، التي تمنت أن يكون سلبيًا، على تصرفات خليلها(أي أنها كانت تبحث في الطبيب عن صفات لا تتعلق بتاتًا بمعرفته العلمية المعيارية). أذكر أنني حين قرأت ذلك، تعجبت من أنها لا تعمم تجربتها في البحث عن طبيب نفسي مناسب، إذ يبدو واضحًا أننا لا نبحث فقط عن طبيب “ممتاز علميًا”، لكن عن شئ آخر في الطبيب يتجاوز الحقل الطبي، نبحث عن يفهمنا ويرشدنا بود واهتمام حقيقين. وليحدث ذلك عليه أن يكون، أو نشعر أنه، راغب في تقديم هذا الإرشاد إلينا تحديدًا. تقول غوتليب أنها لزيادة فرصة قبول المعالجين لها، قالت لصديقتها التي رشحت لها الطبيب أن تخبره أن “المريض” ذو “أداء وظيفي عال”، كشفرة يستخدمها الأطباء النفسيين للإشارة إلى “المرضى الجيدين”، هؤلاء الذين يستطيعون بناء علاقات وإدارة مسئوليات ويملكون القدرة على التفكير بأنفسهم، ولا يتصلون بشكل يومي للإبلاغ عن طوارئ، بتعبير آخر، كانت تحاول أن تخلق “اهتمامًا أصيلًا” عند طبيبها المحتمل.
ليس الأمر فقط أن الحدود مشوشة بين السواء والمرض، ولكن أيضًا بين الطب النفسي والإرشاد الاجتماعي، إذ أن مهمة الطبيب النفسي تعتمد بشكل كبير على قدراته التواصلية، وعلى “فهم الآخر”، أي على بناء “صداقة” مؤقتة معه. ولذلك نبحث عن “معالج” قادر على فهمنا، إننا نعلم مسبقًا أن ما نبحث عنه ليس “معياريًا”، إذ الأطباء النفسيين ليسوا خبراء في كل أنواع العقبات التي قد تسبب آلامنا، ولذلك نعتمد على الصدف بعد التنقل من طبيب إلى آخر أو على البحث واضح الهدف كما فعلت غوتليب.
لكن كما لا تنشأ الصداقة ذاتها، بشكل معياري وقابل للتوقع الإحصائي، لا يمكن أن تنشأ “العلاقة العلاجية” بشكل معياري، لأن هناك طرف مجهول تمامًا في العلاقة العلاجية وهو الطبيب، بينما تفترض الصداقة انكشاف كلا الطرفين[2]. إنني مثلًا قد أخشى من الشكوى من عدم قدرتي على الالتزام الدراسي، أمام طبيب نفسي في أوائل الثلاثينات حاصل على الدكتوراة، إذ أنني سأفترض أنه لم يواجه هذه المشكلة أبدًا. وإذن قد أبحث عن طبيب تأخر حصوله على الدكتوراة، وهذا الأسلوب في البحث، هو في النهاية، رمية زهر. سيخبرني كل طبيب، ألا أهتم بما قد يتفهمونه أو لا، فهذه مهمتهم هم، وقد تدربوا عليها جيدًا. وهو ما يخالف تجربة أغلب الناس مع الأطباء النفسيين(تعميم مجاني مصدره حماسة العبدلله وهو يكتب)، التي تشير إلى الدور الذي يلعبه الحظ والصدف والتجربة والخطأ، للوصول إلى “الطبيب النفسي المثالي”. ومثالي هنا أمر شخصي تماما لا يمكن تعييره.
إلى كل الناس
في المقابل، قد يجادَل بأن الطب النفسي لا يرى مهمته في الإرشاد الاجتماعي(وهي مهمة لها فرعها العلمي المتخصص: الإرشاد النفسي والاجتماعي، وفروعها الشعبية الممتدة من خبراء التنمية البشرية إلى “مدربون الحياة” وخبراء العلاقات )، وأنه يعالج اضطرابات نفسية محددة، كما أنه طور “أخلاقيات مهنية” لا تسمح للطبيب ب”توجيه” المريض إلى خيارات بعينها، بل مساعدته على رؤية الأمور بشكل أوضح ثم اتخاذ القرار بالأصالة عن نفسه، هذا الجدال، يمكن نقده، بأن الطب النفسي، منذ نشأة التحليل النفسي مع فرويد، لم يتوان علمائه لحظة عن الترويج الشعبي له، في كتب ومحاضرات وبرامج تلفزيونية كلها موجهة لغير المتخصصين. إن الحدود الواهية بين الطب النفسي والإرشاد الاجتماعي، إنما أصبحت واهية بفضل الأطباء النفسيين أنفسهم. إذ من البداية، روجت الكثير من مدارس الطب النفسي لنفسها، على أنها تمتلك معرفة تصلح للأسوياء والمرضى. كما استثمر كثير من الأطباء النفسيين “الثقة” في معارفهم العلمية للظهور بمظهر “الناصح المثالي” للشعب. وفي الأخير، تمكنت لغة “الخطاب العلاجي” من الهيمنة في أغلب المجالات، من الإدارة، مرورًا بالعلاقات الزوجية وتنشئة الأطفال والمدارس، وليس انتهاءً بسياسات الحكومات للتعامل مع الخارجين عن القانون. لغة الخطاب العلاجي، المتمركزة حول السواء والمرض، يمكن اعتبارها البنية التحتية للغة الحديث اليومي في مجالات كثيرة.
كل هذه العوامل ساهمت أن نرى أنفسنا كعملاء محتملين للعلاج النفسي، مهما اختلفت مشاكلنا وحدتها. صحيح أن هناك ميزة ظاهرة في التصالح مع تضخم التشخيص النفسي، وهو زوال الوصمة، وشعورنا بوجود سبب “علمي” لآلامنا. وهو ما قد يساهم، على عكس ما يعتقد سميل، في الشعور بأن “العيب” ليس فينا، وإن كان داخلنا.
لكني هذه الظاهرة لا تأتي منفردة، بل يأتي معها ظاهرة آخرها تعاكس أثرها، أننا كثيرًا ما نوحد بين الذات والاضطراب، حتى نصل إلى ظاهرة “التفاخر” باضطرابات نفسية دون الأخرى، خاصة حين يشير الإنتاج المعرفي الشعبي في الطب النفسي، إلى تلازم بعض الاضطرابات مع بعض القدرات غير الاعتيادية، وإذن يصبح هناك “سوق” للاضطرابات للنفسية، تكون فيها بعض الاضطرابات ذات قيمة سوقية عالية، وأخرى ذات قيمة منخفضة. لهذا نرى من يفتخر أن لديه “اضطرابا نفسيًا” ما، لاعتقاده أن ذلك دليل على عبقريته وعلى اختلافه. وإذن تعود المشكلة إلى الذات وليس فقط إلى الداخل.
هذه الطريقة المزدوجة للتعامل مع الاضطرابات النفسية، تضعنا في ارتباك، فمن جهة إذا كنا مصابين باضطراب نفسي ما، ف”ذواتنا” نفسها غير معطوبة، لكن تغلغل “الخطاب العلاجي” في مفرداتنا اليومية، يجعل “اضطراباتنا” جزء أساسيًا من طريقة فهمنا لذواتنا، ويخترق الطريقة التي نُعرّف بها ذاتنا، أمام أنفسنا وأمام العالم.
الكلام والصمت
أحد الأفكار الرئيسية في الخطاب العلاجي الموجه إلى الجمهور، فكرة الكبت. أننا قررنا دفن أمور عميقًا داخل أنفسنا، لعدم استطاعتنا التعامل معها في وقت حدوثها، لكنها على ذلك، تظل متحكمة ومرشدة لكيفية تفاعلنا مع العالم. وبالتالي يساعد “الكلام” على إخراج جثث “الموتى الأحياء” من قبورها والتخلص منها، مرة وإلى الأبد. والكلام المسترسل هنا هو النور الذي يكشف أماكن هذه القبور. يعدنا الخطاب العلاجي، بأننا كلما تكلمنا وتأملنا في عواطفنا، كلما كنا أكثر قدرة على مواجهتها(هذه المرة مسترشدين وممدودين ب”المعرفة” العلاجية لدى الأطباء)، وهو ما تلخصه الجملة الجميلة لعلاء خالد: “الحكاية علامة شفاء الراوي”. وما أتساءل عنه، إن كان الكلام المستمر عن حدث أو اضطراب معين، بوسعه أن يزيل، دائمًا، آثار هذا الحدث، وليس أن يجعله المحور الدائم لحياتنا. فبما أننا مضطرون للكلام الدائم عن عواطفنا، للتعافي، فإننا، في الوقت الحاضر، علينا أن نكون معطوبين(الحكاية صحيح علامة شفاء الراوي، لكن لا سبيل لنا لنكون “جديرين” بالحكي، دون أن نكون مرضى في البداية، ويمكننا إعادة صياغة الجملة لتصبح أكثر دقة: الحكاية علامة شــــ(ف/ق)ــــاء الرواي). بالطبع، تجاوزت مدارس عديدة للعلاج النفسي الكلامي، كالعلاج المعرفي السلوكي، التمركز القديم للطب النفسي حول الماضي. وبدلًا من ذلك، تركز على الحاضر وصعوباته، والتغيير الذي يريده الفرد، وتكون مهمة “الكلام” هو أن يتبصر المرء بما يريد فعلًا تحقيقه، والأهم، أن يعيد صياغة تصوراته عن نفسه والعالم، بشكل يجعلها أكثر نجاعة في التفاعل مع العالم. لكنها تشترك في فكرة، أن “العطب” يكمن في الداخل، هذه المرة في تأويل المرء لحياته، وإذن “العلاج” يأتي بإصلاح هذا “العطب الداخلي”.
لم تتزعزع مكانة “الكبت” شعبيًا، لأنه يعطينًا شيئًا فريدًا، وهو القدرة على أن نحكي، ولو عن طريق اتباع مخططات عامة لكيفية نشوء الاضطرابات، إننا نصبح أكثر قدرة على سرد ذواتنا، ونحظى بجوار ذلك بوعد أن هذا السرد، بذاته، سيحررنا. لهذا فإننا، جميعًا(نفس المصدر السابق)، نخبر أصدقائنا في أوقات شقائهم، أننا موجودين دائمًا في أي وقت “للاستماع” إلى حكايتهم.
العطب الجماعي
ورغم أن فكرة أن كلنا “معطوبون” نفسيًا، قد تجعلنا أكثر قدرة على تفهم آلامنا الشخصية وآلام الآخرين. إلا أنها أيضًا قد تجعلنا أقل قدرة على “التعافي”، مادمنا قد وحدنا بين الاضطراب وذاتنا نفسها. وفي بعض الاضطرابات النفسية، قد يفاقم هذا التوحيد من صعوبة الآلام. إذ قد يبدو، أحيانًا، الألم الناتج عن الاضطراب أبديًا لا يمكن مراوغته إلا بالهرب من الذات نفسها.
إن الفكرة الرئيسية في رأيي، للعطب النفسي، تكمن في افتراض أننا لا نستطيع أن نتعامل مع بعض الظروف والمواقف “تعاملًا سويًا”، وبالتالي يخترقنا شعور أن الألم النفسي هو دائمًا نتيجة لسوء التعامل هذا، رغم أنه قد يكون، كما يشير فرانسيس في كتابه، نتيجة طبيعية لمواقف صعبة، فموت قريب أو حبيب، من الطبيعي أن يجعلنا عاجزين عن العودة فورًا ل”الحياة العادية”، هذا الألم لا يمكن الهروب منه، وهو ليس ناتجًا عن عطب نفسي، بل قد يكون العطب النفسي فعلًا هو أن نحيا بشكل اعتيادي بعد خسارة فادحة. ويشير فرانسيس أن كثيرًا من آلام الحياة، بإمكاننا تجاوزها مع مساعدة القريبين منا، وهي مساعدة تأتي محملة بخبرات مجتمعية تاريخية عن كيفية التعامل في هذه الظروف.
إنني أفكر أحيانًا، أن الطب النفسي الشعبي، قد منحنا هدية عظيمة لا تقدر بثمن، وهو أن نمتلك “الحق في الألم” و”الحق في الشكوى”، وأن هناك “خبراء” و”علماء” يؤكدون لنا أن ما نعانيه ليس وهمًا، لكنها هدية تفخخ نفسها إذا أفرطنا في استعمالها، إذا ربطنا بين كل ألم نفسي وبين وجود عطب ما. فأحد آثار انتشار الخطاب العلاجي، إن هذا “الحق في الألم” لا نأخذه إلا بعد تكوين قصة عن حياتنا، نكون فيها ضحايا، لصدمة في الصغر، لإساءة، لاضطراب نفسي متوارث جينيًا، لازدراء عنصري، أو غير ذلك، كأن “العادي” في الحياة، ألا نتألم أبدًا. وما افكر فيه أنه ربما يكون لنا الحق في الألم، دون أن نكون معطوبين(أي نستعيد حقنا في حكاية خالية من العطب النفسي). وربما يكون جزء من الأزمة ، في الصورة المثلي للحياة الخالية من الألم التي نستبطنها ك”حياة عادية”، وهي الصورة التي تجعلنا نشعر كلما تألمنا بالعطب(كأن الألم شئ طارئ وغير مفهوم)، وهي صورة حديثة، بمعنى أنه كان هناك دومًا ثقافات ترى الألم جزء من “الشرط الإنساني” نفسه.
لا يعني “الألم” غير الناتج عن اضطراب نفسي، أنه ألم خفيف أو يمكن تجاوزه دون مساعدة، ولكن هذه المساعدة لا يشترط أن تأتي من الطب النفسي. يقول سميل، أن “التضامن” الذي نجده عند أطبائنا النفسيين، أو عند أصدقائنا، غالبًا ما لا يمكنه التأثير في حقول القوة البعيدة، وبالتالي يكتسب تأثيره بالأساس من استمراريته، هذه الاستمرارية لا يمكن رهنها بالطبيب النفسي، الذي هو في النهاية مقدم خدمة محترف يتلقى أجرًا(الأجر الذي يضغط بدوره على ميزانيتنا الواضعة، ويجعلنا مضغوطين نفسيًا)، إنما برعاية بعضنا البعض، وإحياء ثقافة التضامن الجماعي المنذثرة، العائلة والأصدقاء والأزواج، إننا لا نستطيع النجاة أبدًا كأفراد، مهما كانت شروط الحياة يسيرة وسهلة.
الأنانية
لطالما هوجمت خطابات الطب النفسي الشعبية، لترسيخها الأنانية عند الناس، عن طريق النصح بالابتعاد عن أي مصادر محتملة للألم، ونتيجة هذا الابتعاد غير المباشرة، هي “عزلة” الفرد عن أي مصادر للتضامن الاجتماعي. وبالتالي لا سبيل له لاكتساب التضامن إزاء محنه سوى الطب النفسي. هناك وجاهة في هذا النقد، وقد يكون التصالح مع الألم كأحد معطيات الحياة الأولية، قادرًا على زيادة احتماليتنا له.
مع ذلك، تتضمن تلك النصيحة نفسها، حدسًا حقيقيًا لا يمكن تجاهله. إن لدينا جميعًا قدرة احتمالية معينة، وعلينا عدم زيادة التحميل على أنفسنا، حتى لا نصل لنقطة الانكسار، وهي النقطة التي سنصبح فيها، أيضًا، عاجزين عن إبداء اي تضامن أو مساعدة للآخرين. “الأنانية” بالقرب من نقطة الانكسار، هي فعل إيثاري تمامًا في رأيي. لكن المشكلة، أن الشعور بالعطب الدائم، قد يجعلنا نفترض نقطة انكسار بعيدة جدًا عن نقطة الانكسار الحقيقية. وبالتالي نقلل من قدرتنا على مساعدة أنفسنا والآخرين، حين ننكسر، أو نظن أننا سننكسر، مبكرًا جدا.
“شد حيلك”
السبب الخامس لانتشار خطاب الطب النفسي، في رأيي، أنه يتحدث في أمور نشعر أن لدينا الخبرة والمعرفة الكافية لفهمها والجدال فيها. إننا لا نقضي ساعات طويلة نفكر في كيفية زيادة كفاءة الكبد أو القلب، لكننا نقضي حياتنا كلها ونحن نفكر في كيفية خلق حياة أفضل وأقل ألمًا. لهذا تبدو كثيرًا من “نصائحه الشعبية” كأننا نعرفها مسبقًا، لأننا بساطة نعرفها مسبقًا. لكن “النصيحة” ليست مفيدة قدر جدتها وعبقريتها، هي مفيدة بقدر عمليتها. إننا في أحيان كثيرة نعلم “الحلول النظرية السليمية” لمشاكلنا، ولكننا نفتقد القدرة والإرادة على البدء بتنفيذها، لأن هذه القدرة والإرادة مرتبطين بموقعنا في العالم وقوة بصيرتنا.
في كتابه، يقول سميل، إن العلاج النهائي الحقيقي لشقائنا، هو أن نمتلك المزيد من المميزات أو القوة في المحيط الذي يؤثر فينا(بتعبير آخر، تغيير التموقع الفردي داخل الشبكات الاقتصادية والاجتماعية). لكن مع كل الاحترام يا أستاذ سميل، هذه هي المشكلة وليست الحل. بشكل كاريكاتوري، يمكنني أن أرى سميل في معسكر أعداء “معلشي”، إنه يريد حلولًا حقيقية على أرض الواقع. مع ذلك، فإن نصيحته ليست عديمة الجدوى تمامًا. إن صديقي حين يشكو لي ظروف عمله شديدة الصعوبة بمقابل مادي زهيد، لا ينتظر أن أقول له الحل العبقري: إذا كنت محتاجًا لهذا المال الزهيد، فلا تستقل قبل أن تجد عملًا آخر، وفي الأثناء، طور مهاراتك المهنية، وقدم سيرتك الذاتية لكل شركة في هذا العالم، هكذا ستتضاعف فرص عثورك على منفذ ما. هذه نصيحة مثالية، وبالفعل أغلب حلول مشاكل الشقاء تكمن في الاجتهاد لزيادة مساحة نفوذ الفرد وشبكته الاجتماعية في العالم على المدى الطويل. وما يبحث ويسأل عنه صديقي فعلًا هو إذا كنت من موقعي المختلف عنه في العالم، قادرًا على رؤية مهرب ما لا يستطيع هو رؤيته، شركة جديدة تطلب موظفين، أو منحة دراسية، أو حتى إذا كنت قادرًا ماليًا على مساعدته إلى حين يتمكن هو من إيجاد عمل جديد. أنا وصديقي تزداد احتمالية أن يبصر أحد ما منفذا للنجاة، وينصحنا به، كلما زادت دائرة تضامننا الجماعية، وكلما أصبحنا أكثر رغبة في إبداء مساعدة “حقيقية” تجاه البعض بعضنا، إنه أمر بديهي تمامًا، كما أخبرتك.
من ينتج الخطاب العلاجي
أخيرًا، هناك سؤال مربك بخصوص كيفية إنتاج المعرفة الخاصة بالطب النفسي. فالطب النفسي، يختلف عن غيره من فروع الطب، أنه لابد أن يحمل تبصرًا نفسيًا واجتماعيًا، وهو تبصر محدود بالأفق المعرفي والخبرة العملية والصفات الشخصية، لهؤلاء المتبصرين. نحن نتحدث عن شريحة ضيقة جدًا من الطبقات الوسطى والعليا القادرة على إكمال مسار تعليمي شاق وطويل، وهو ما يحتاج لصفات شخصية أصيلة أو مكتسبة لديها حد أدنى من القدرة على ضبط الذات، ثم هذه الشريحة محصورة بالمعرفة المسبقة الموجودة حولها، وهي تعيش في شرائح اجتماعية لديها أفكارها عن معاني النجاح والفرد والأسرة والزواج والأخوة والتضامن، والأهم من كل ذلك، أن لديها حدسًا بماهية “الحياة العادية” و”الصعوبات العادية”، وهي أمور تختلف جدًا من مجتمع إلى الآخر، لأنني أعتقد أن المجتمعات المختلفة، اقتصاديًا وثقافيًا، تقطع وعودًا مختلفة لمواطنيها(وإن كان العالم الحديث/الرأسمالية تمكن من إنتاج وتوزيع رغبات متطابقة على جميع العالم، فإن كل مجتمع يظل منتجًا لرغبات خاصة لا يتم تصديرها لأسباب معقدة)، وتخلق أيضًا أنواعًا من الألم النفسي(لأن حقول القوة وطرق عملها، فيها الكبير الذي يؤثر فينا جميعًا، وفيها المحلي الذي لا يتجاوز محيطه).
إننا نظل بشرًا في النهاية، ولهذا نحن نفهم ونتأثر هذا الخطاب، ما أقوله فقط أنه يجب أن يكون لدينا درجة من الشك في “عمومية” و”صلاحية” هذا الخطاب(صحيح أن الطبقات الوسطي في عالم ما بعد العولمة تشترك في أمور كثيرة تجعلها قادرة على مخاطبة وفهم نفسيات بعضها البعض بشكل كبير، لكننا لا يجب ألا ننسى، أننا ، حتى بافتراض أننا نواجه نفس العالم، فإننا لا نواجهه من نفس الموقع، وهناك متغيرات تؤثر في كيفية بناء ذواتنا وتماسكها).
ليس عندي أي رفض للخطاب العلاجي، وبالعكس أرى في زيادة استهلاكه مهما كانت “سطحية” نسخه الشعبية مفتاحًا لجدل صحي حول سعادتنا وشقائنا ومعنى الحياة(وهو الجدل الذي أشارك الآن فيه)، ولكن عندي أمل كبير أن ينجح أكثر في استيعاب نظرات مختلفة للعادي والمرضي، وأن يساهم هذا الاستيعاب في تطوير إرشادات أكثر خصوصية ونجاعة، وبالتالي المساهمة في إنشاء ثقافة قادرة على خلق “نفسيات” أكثر تماسكًا، حين لا ينحصر إنتاجه في مجتمعات وجامعات بعينها(للدقة أكثر: تكون تلك الجامعات بجانب قدرتها الكبيرة على الإنتاج، أكثر قدرة على “توزيع وتسويق” منتجاتها، وإلا فإن إنتاج “الخطاب العلاجي محليًا أو خارج تلك الجامعات، مستمر دومًا، لكنه لا يحصل على نفس الجدارة أو الثقة أو الانتشار، وبالتالي لا تتراكم مجهوداته البحثية عبر الزمن)، خاصة أنه ليس هناك معايير علمية لقياس نجاعته من عدمها، بتعبير آخر، أغلب نظريات علم النفس، نظريات غير قابلة للتكذيب، وأقصى ما يمكن عمله لاختبارها، هي الاختبارات الإحصائية(كم من المصابين باضطراب معين قال إنه شعر بتحسن بعد معالجته بطريقة محددة، مقارنة بنفس النسبة من العينة المعيارية)، هذه الاختبارات الإحصائية، كثيرًا ما، لا تنتج “علمًا” بالمعنى النيوتني، وإنما “تميل” إلى هذه النظرية بدلًا من تلك(خاصة إذا نتائج هذه الاختبارات تتراوح حول القيم الوسطى). عدا طبعًا عن أن نتائج الإحصاءات نفسها، يمكن أن تنتج تفسيرات بلا نهاية.
لقد حاول علماء النفس بالفعل، تنويع مصادر معرفتهم عن النفس واستدخال تقنيات من مجتمعات غير غربية في “الخطاب العلاجي”، لكن هذا التنويع كان محدودًا هو نفسه بالمعارف المتاحة لهم، هكذا مثلًا لا يمكن رؤية استدخال كثير من المصطلحات والتقنيات الآتية من الثقافات الشرقية، خاصة الهند واليابان والصين، من أشهرها مثلًا تقنية “اليقظة الكاملة”، مع إهمال أن هذا الاستدخال جرى نتيجة انتشار معلمي هذه التقنيات، في عقد السبعينات في الولايات المتحدة.(وهذا دون أن نبدأ في الحديث في النقد الموجه لاستدخال هذه التقنيات دون “منظومتها المعرفية” التي منها تكتسب المعنى).
“الشك” في عمومية وصلاحية “الخطاب”، لا يمكن أن ينفصل أيضًا عن “الشك” في نقد عموميته. فكثيرًا ما يكون نقد “التحيزات الثقافية” في الخطابات المعرفية، يجري لصالح ترسيخ “الثقافات المهيمنة محليًا”(الدفاع عن سلطة مساحات الإرشاد الاجتماعي التقليدية، والتي فقدت هي نفسها نجاعتها وبصيرتها التاريخية). فنجد أنفسنا نطرح سؤالًا مشابهًا، من ينتج الخطاب الناقد للخطاب العلاجي، وما هي حدوده المعرفية وتحيزاته الاستراتيجية هو الآخر. ففي رأيي، تقع الخطابات الناقدة للمركزية الغربية، كثيرًا، في نفس فخ المركزية الغربية، بافتراضها أن “حقل القوة” الغربي، الذي يختبرونه بصفتهم في النهاية يعملون في جامعات غربية وينتجون معرفة مستندة على “جدارتهم” المختومة بختم تلك الجامعات، هو حقل القوة العالمي الوحيد، وسبب كل آلام العالم، في الوقت، الذي يعتبر سكان العوالم الأخرى، غير الغربية، حقول قوة ثقافية أخرى، هي حقول القوة المركزية بالنسبة إليهم.
[1] الأثر الاقتصادي المباشر، لتضييق مساحة السواء، هو توسيع شريحة العملاء المحتملين للطب النفسي، وبالتالي زيادة الطلب عليه، بشكل يرفع من أسعار خدماته.
[2] الصداقة بين المعالج والمريض، تجد حدها الواضح في “المقابل المالي” الذي يدفعه المريض لتلقي خدمة بعينها. هذا “المقابل” يساهم، حسب ما أفهم من الخطاب العلاجي، في عدم حدوث تحويل للمشاعر من المريض إلى الطبيب، لكنه أيضًا يضع حدًا لقدرة “العلاقة العلاجية” نفسها، إن هو تذكير بأن “التضامن” ليس حقيقيًا بالضرورة. وهو الأمر الذي تتخطاه الصداقة، أو الإرشاد الاجتماعي التقليدي، الذي غالبًا ما يكون مجانيًا، أو حتى مقابل محض الاعتراف بسلطته. إن “الأجر” ضروري من حيث هو مقابل خدمة ومعرفة يقدمها الطبيب، بعد تحصيلها على مدى سنوات طويلة، لكن، ضروريته ، أمر مختلف تمامًا عن إدعاء “قيمته العلاجية”.